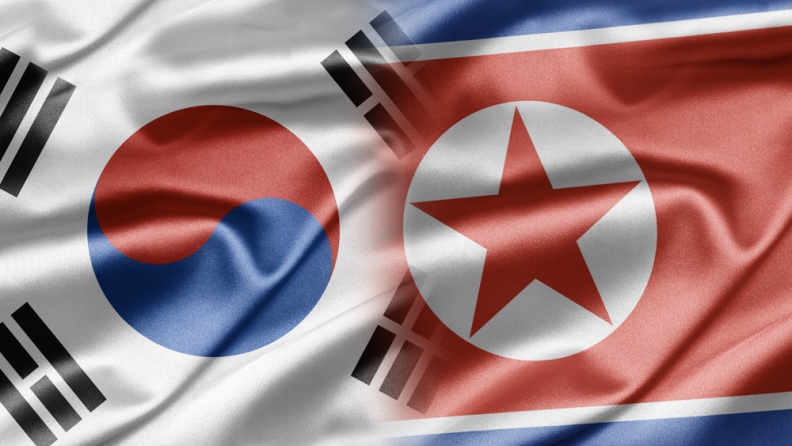عام عربي جديد .. مناعة أقل ومتربصون كثر
يتوقع أن تعرف السنة الجارية، على غرار العام الذي ودعناه، الكثير من التغييرات بعضها متوقع وأغلبها عكس ذلك. فمثلا لن تستطيع روسيا وإيران إعادة بناء سورية، وحل مشكلات الحياة واللاجئين فيها، بل المنتظر أن الفشل الروسي الإيراني في الجبهة السورية لن يقل في حجمه عن الفشل الأمريكي في كل من العراق وأفغانستان.
يبقى الغموض عنصرا قائما في ما ينتظر العالم العربي، مع كثير من التعقيدات والالتباس المتعلق بمستقبل دول عربية؛ أو على الأقل أجزاء منها، في خضم بحر عدم الاستقرار والسخط الشعبي المتنامي بفعل الأزمة المالية المتفاقمة في جانب، وغياب آليات الإصلاح السياسي أو توقفها عن العمل مفسحة المجال لعودة السلطوية في العديد من البلدان في جانب آخر.
ما يزيد من نسب احتمال سيناريو تغييرات مفاجئة في المنطقة العربية، هو تنامي سرعة وحجم الانكسارات التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة، لدرجة تحولت فيها الوضع إلى ما يشبه الحمى أو "الإنفلوانز" التي تنتقل بشكل قياسي هنا وهناك؛ متى أدركت أن هناك ضعفا في المناعة أو ظهر لها أن منسوب المقاومة، والقدرة على التصدي ضئيل.
منذ تكثيف الضربات على تنظيم داعش في العراق والشام، تعيش العديد من البلدان؛ عربية وغربية، على وقع موسم عودة أبنائها المتطرفين ممن خاضوا تجربة القتال في صفوف تنظيم داعش ردحا من الزمن. فالتقارير الاستخباراتية المتداولة على أكثر من صعيد لا تبشر بخير أبدا، حيث تفيد بأن أعداد العائدين في تزايد، وقائمة الدول التي يتركزون بها تكبر. فعلى سبيل المثال دولة صغيرة كتونس سجلت عودة 600 مقاتل إليها، وقس على ذات المنوال بخصوص بقية الدول، ما يعني أن المنطقة تعيش على وقع هذه "القنابل الموقوتة" على حد تعبير ماركوس سيلر رئيس الاستخبارات السويسرية.
#2#
وربما يتحول هذا الأمر إلى استراتيجية "بعقر دارك تكون المعارك" على حد وصف براين جوكينس الباحث بمؤسسة راند، في تقرير له عن ظاهرة عودة الجهاديين إلى أوطانهم. وبشكل خاص عندما يتمكن هؤلاء المتطرفون من استغلال هوامش البيئة الحاضنة المنتشرة في دول عربية، بسبب التهميش والبطالة والقمع من أجل الحشد والتعبئة لتوجيه ضربات مفاجئة، وربما احتلال مدينة أو مدينتين بعيدا عن المركز في أقاصي هذه الدولة أو تلك، ما يجعل الإقليم العربي على كف عفريت.
يعضد هذا الخطر الإرهابي المتنامي ويدعمه بروز معالم توجه جديد في الصراع الدولي الراهن، يقوم على خطة أساسها تعددية في جبهات الصراع وبؤر التوتر التي يمتلكها كل طرف، بغية ضمان أوراق كثيرة عند الجلوس على طاولات التفاوض واقتسام النفوذ بين القوى الكبرى.
إنها ما يعرف في قاموس العلاقات الدولية بمفهوم الحرب بالوكالة، التي يعيش العالم الآن على وقع عودتها أو بالأحرى انتعاشتها. وتعني في أبسط تعريفاتها تنافس بين قوى كبرى (إقليمية أو دولية) على النفوذ في منطقة معينة أو عدة مناطق في العالم، وتحاول هذه القوى أن تتجنب حروبا مباشرة بينها، فتبدأ في زيادة نفوذها من خلال التدخل في بعض الدول الأصغر، التي تمثل قيمة استراتيجية أو جغرافية أو اقتصادية، أو تقوم بدعم بعض الجماعات أو الأحزاب السياسية لإسقاط أنظمة معادية لها، أو مواليه لأعدائها.
ما يجعل المنطقة العربية مرشحة بحدة لتزايد مناطق الصراع بها، وجبهات الحرب بالوكالة فيها. فكل طرف يسعى من موقعه إلى تسجيل الحضور بشكل من الأشكال (تدخل مباشر، دعم غير مباشر، احتضان فصيل ...) عند ظهور بوادر لأي صراع بالمنطقة. هذا وتبقى بعض الصراعات في أصلها محلية الطابع (قبلية، طائفية، دينية، سياسية ...) لكنها سرعان ما تتعرض للتدويل بمجرد ما يدخل اللاعبون الكبار على الخط.
لكن نظرة في استثناءات هنا وهناك بالإقليم العربي، التي نسيناها في غمرة العنف والحرائق والفتن، تعطي فسحة أمل بممكنات أخرى غير لغة الحرب، وتوحي إلى طريق آخر؛ أو بالأحرى سيناريو أفضل، يمكن لهذه البلدان أن تعيش على وقعه؛ إنه خيار الحراك الشعبي السلمي.
ما وقع في السودان أخيرا مؤشر مهم لاستمرار دور مدرسة التعبير السلمي الديمقراطي في العالم العربي، فتجربة السودان مع العصيان المدني تشير إلى القدرة الشعبية على تفادي العنف واستخدام التظاهر والإضراب والتجمع والتمسك بالحريات من أجل التغيير.
وقبله كان المغرب على موعد مع حراك مدني سلمي عم أزيد من 20 مدينة مغربية نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر)، عقب مقتل محسن فكري بائع السمك؛ بمدينة الحسيمة شمال المغرب بطريقة شنيعة.
ويبقى أفضل خيار لمواجهة كافة الأخطار والتصدي للمتربصين خارجيا، وممثليهم بيننا ممن ديدنهم التقية، هو ذاك الذي دخلت فيه دول عربية، والقائم على إصلاحات هيكلة كبرى تؤطرها رؤية وطنية شاملة، تقطع الطريق أمام كل محاولات الاستغلال التكفيري والتغلغل الأجنبي أو الإقليمي والاستغلال المحلي التي تهدد المنطقة العربية.