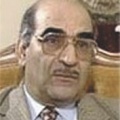العقل ... علوم مخصوصة
بينا في المقال السابق كيف أن الرؤية البيانية للعالم لا تعتبر العقل "جوهرا" – كما تقول بذلك الفلسفات القديمة - بل تعتبره مجرد فاعلية ونشاط أي مجرد "عرض"، كما ترى أن "القلب" هو أداة هذه الفاعلية وعضوها وليس الدماغ! ثم تساءلنا في نهاية المطاف: هل يعتبر المتكلمون أن هذا الأخير، أي "القلب"، هو الجوهر الذي يقوم به ذلك العرض (العقل) باعتبار أن العرض عندهم لا يقوم بنفسه، بل لا بد من محل يقوم به؟
ونريد في هذا المقال أن نتعرف على رأيهم في هذه المسألة.
يمكن القول مبدئيا إن العلاقة الوظيفية التي تقيمها اللغة العربية بين القلب والعقل مستمرة في خطاب المتكلمين، بل يمكن أن نلاحظ، أكثر من ذلك، أنهم يستعملون لفظ "القلب" بمعنى "العقل"، كما في اللغة تماما، وإذا أرادوا التمييز بينهما عادوا إلى المعنى/البياني/الأصلي فجعلوا القلب أداة والعقل وظيفة له. ولا فرق في هذا بين المعتزلة والأشعرية وغيرهم من البيانيين. وكما هو الشأن في المسائل الكلامية الأخرى فلقد كان المعتزلة هم الذين وضعوا لهذه المسألة، مسألة العلاقة بين القلب والعقل، إطارها النظري داخل نظريتهم في الجوهر الفرد.
ذلك أنهم يرون أن العلم، مثله مثل الإرادة، عرض يعرض على القلب، فهو مثله من "أفعال القلوب"، ويستدل أبو هاشم الجبائي على ذلك بكون فاعل الإرادة والفكر يفزع إلى ناحية قلبه وأن في ذلك دلالة على أن محلهما القلب". فالإرادة لا تَحلُّ باليد ولا بالدماغ بدليل أن المريد لا يفزع إليهما فيها، وكذلك الشأن في العلم، فليس محله الدماغ كلما يقول الفلاسفة، لأنه "لو حل العلم في الدماغ لوجب في الوز والسمك البحري ألا يحصل لهما علم البتة لأنه لا دماغ لهما، (هذا في حين أن لهما "علم" يميزان به ما يؤكل عما لا يؤكل ويعرفان به الطريق إلخ). غير أن القاضي عبد الجبار الذي أورد هذا عن شيخه يشك في وثاقة هذا الدليل فيعترض عليه متسائلا : "وهل هذا الكلام إلا كقول الأوائل إن العلم يحل بالدماغ لأن المفكر يطرق رأسه ويفكر ويفزع إلى دماغه كفزعه في الكلام إلى لسانه". وهكذا، فكما أنه لا يصح اتخاذ كون الإنسان يطرق رأسه عند التفكير دليلا على أن محل التفكير هو الدماغ فكذلك لا يصح اتخاذ كونه يفزع إلى قلبه، حين الإرادة والعلم، دليلا على أن محلهما القلب. من أجل هذا يرى القاضي عبد الجبار أن كون القلب محلا للعلم مسألة لا دليل عليها من جهة العقل وإنما دليلها السمع. ومع ذلك فهو يرى أنه لا يمتنع معرفة كون الإرادة والفكر- لا العلم - محلهما القلب معرفة استدلالية باعتماد "ضرب من الدليل: وهو أنّا نعلم أنه قد يلحق الفاعل في ناحية قلبه بعض التعب عند الإرادة والفكر، فلا يبعد أن يعلم بذلك حلولهما في هذه الناحية، وإن كان في تفصيل ذلك يرجع إلى السمع وهو قوله تعالى : "لهم قلوب لا يفقهون بها".
وهكذا، واعتمادا على هذا الدليل السمعي وعلى ما قد يلتمس له من شواهد مؤيدة، يرفض المعتزلة أن يكون محل العقل الدماغ كما يقول الفلاسفة، بل يربطون بين العقل والقلب ويجعلونهما بمعنى واحد، وكثيرا ما يفضلون عبارة "النظر بالقلب" على عبارة "النظر بالعقل". فأداة النظر والتفكير والتأمل عندهم في القلب. يقول القاضي عبد الجبار: "ثم إن النظر بالقلب له أسماء، من جملتها : التفكير، والبحث، والتأمل، والتدبر، والرؤية وغيرها". وهو يميز في "النظر" بين نظر البصر ونظر القلب، وحقيقة هذا الأخير عنده هو الفكر، لأنه لا ناظر بقلبه إلا مفكرا، ولا مفكرا إلا ناظرا بقلبه، وبهذا تعلم الحقائق".
ومن المسائل التي أثارها المتكلمون في هذا الصدد مسألة ما إذا كان "كل قلب يحتمل أي علم كان" أم أن القلوب تختلف في احتمالها للعلوم والمعارف باختلاف المزاج الذي يكون عليه القلب. يقول النيسابوري في هذا الشأن: "ذكر أبو القاسم (البلخي المعتزلي) أن بعض القلوب، لما يرجع إلى المزاج، لا تحتمل"كل العلوم، خصوصا العلوم الدقيقة اللطيفة". ويعترض عليه النيسابوري قائلا : "وعند شيوخنا (المعتزلة) أنه لا قلب إلا وكما يحتمل بعض العلوم يحتمل سائرها". ويضيف: "والذي يدل على صحة ما قالوه : إن العقل وسائر العلوم سواء في أنه لا يحتاج في وجوده إلى أكثر من بنية القلب، فإذا كان القلب مبنيا البنية التي يجوز أن يوجد معها شيء من الاعتقادات، فقد وجد فيه من البنية ما يحتاج كل عالم منا إليه". وإذن فالقلب، أيا كان، يحتمل أي علم كان، ولا دخل للمزاج في ذلك!
ليكن، ولكن ما المقصود بـ "بنية القلب" هنا؟
البنية عندهم هي "تأليف واقعٌ على وجه ما". وبنية القلب "لا تتم إلا بمجموع أمور". ومن أجل بيان هذه "الأمور" لا بد من التنبيه أولا إلى أن ربط العقل ببنية القلب ورفض ربطه بمزاجه أملته الرغبة في تجنب الانسياق مع فكرة "الطبع"، التي تبناها بعض المعتزلة، ومنهم أبو القاسم البلخي كما أشرنا إلى ذلك في مقال سابق. كما تجدر الإشارة هنا إلى أن المتكلمين يتجنبون استعمال كلمة "غريزة" عند الكلام عن العقل لنفس السبب، لأن الغريزة تحمل معنى المزاج وبالتالي معنى الطبع. ومن أجل أن يتجنبوا أيضا القول بأن العقل جوهر كما يقول الفلاسفة، نجدهم يلجأون إلى المطابقة بين العقل والعلم فيقولون : العقل "جملة من العلوم مخصوصة" تحصل في قلب الإنسان فتبنيه البنية التي يصبح بها قادرا على اكتساب معارف وعلوم أخرى بالنظر والاستدلال. يقول القاضي عبد الجبار في هذا الشأن: "اعلم أن العقل هو عبارة عن جملة من العلوم مخصوصة متى حصلت في المكلف صح منه النظر والاستدلال والقيام بأداء ما كلف". ويرد على من يقول إن العقل جوهر بكون الجواهر متماثلة متجانسة وأنه لو كان العقل جوهرا لكان الشخص العاقل -المؤلف جسمه من جواهر- هو نفسه عقلا أو لكان عاقلا بسائر أجزائه. أما القائلون بأن العقل "آلة" فيرد عليهم بأن الآلة "في اللغة والاصطلاح لا تجري إلا على الأجسام" (الآلة عندهم هي العضو الجسماني كالجوارح واليدين...)، والعقل ليس بجسم لأنه لا يمكن أن يكون جوهرا كما قدمنا، والجسم مؤلف من جواهر. ونفس الشيء يرد به على القائلين إن العقل حاسة، لأن الحاسة "إنما يعبر بها عن جسم مبني بنية مخصوصة كبنية العين والأذن، وذلك لا يصح في الأعراض"، والعقل عرض كما نعرف. ويرد على القائلين إن العقل "قوة"، بأن القوة معناها القدرة، وأنه لو كان العقل قدرة على العلوم تحصل في العاقل لكان العاقل عاقلا وإن لم تحصل فيه "العلوم المخصوصة" التي تجعل منه عاقلا، لأن القدرة متقدمة على الفعل، هذا في حين أن الواحد منا لا يكون عاقلا إلا إذا حصلت فيه "علوم مخصوصة".
وهذه العلوم المخصوصة هي مثل أن يكون الواحد منا "عالما بما يدركه ويعلم من حالة أنه لو أدركه غيره لعلمه، إذا لم يكن هناك لبس" و"أن يعرف من حال المدركات التي هي الأجسام ما تحصل عليه من كونها مجتمعة أو مفترقة ومن استحالة كونها في مكانين لأنه متى لم يعلم ذلك لم يسلم له من العلوم ما يجري مجراها ولا يصح منه الاستدلال على إثبات الأعراض وحدوثها وحدوث الأجسام وتعلق الفعل بالفاعل لأن كل ذلك يستند إلى هذا العلم .. وعلى هذا الحد يجب في العاقل أن يكون عالما بأن الجسم لا يجوز أن يكون قديما محدثا ولا الشيء معدوما". ولا بد أيضا من "أن يعرف "بعض المقبحات وبعض المحسنات وبعض الواجبات، فيعرف قبح الظلم وكفر النعمة والكذب الذي لا نفع فيه ولا دفع ضرر، ويعلم حسن الإحسان والتفضل... فهذه الجملة (من المعارف) إذا حصلت في الحي منا كان عاقلا" ... وإنما يوصف المرء بكونه عاقلا لوجهين : أحدهما أنه يمنع من الإقدام عما تنزع إليه نفسه من الأمور المشتهاة المقبحة في عقله، فشبه هذا العلم بعقل الناقة المانع لها عما تشتهيه من التصرف، والثاني أن معه تثبت سائر العلوم المتعلقة بالفهم والاستدلال، فمن حيث اقتضى ثبات سائر العلوم المتعلقة بالفهم والاستدلال شبه بعقل الناقة المقتضي لثباتها".
ملاحظة: لا شك أن من لهم اطلاع على نظرية المعرفة عند الفلاسفة منذ أرسطو حتى العصر الحديث سيلاحظون أن مفهوم "العلوم المخصوصة" هو نفسه مفهوم "مبادئ العقل"، وأن هذا النوع من النقاش قد بقي سائدا في الفكر الفلسفي الأوروبي حتى القرن الثامن عشر.