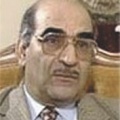الرؤية البيانية ترفض فكرة "الضرورة العقلية"
عرضنا في المقال السابق موقف المعتزلة من تحديد معنى العقل. ونريد الآن أن نتعرف على موقف الأشعرية فنقول: لا يختلف موقف الأشعرية في هذا الموضوع عن موقف المعتزلة في شيء سوى أن بعضهم يستعمل عبارة "بعض العلوم الضرورية"، بدل عبارة "علوم مخصوصة" التي استعملها شيخ المعتزلة في عصره القاضي عبد الجبار (المقال السابق). يقول أبو يعلى الحنبلي الذي يحذو في المسائل الكلامية -في الغالب- حذو الباقلاني المنظر للمذهب الأشعري: "والعقل ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض واحد، بل هو بعض العلوم الضرورية، خلافا للفلاسفة في قولهم إنه جوهر بسيط، وخلافا لبعضهم في قولهم إنه مادة وطبيعة، وخلافا لقوم آخرين في قولهم إنه قوة يُفصل بها بين حقائق المعلومات، وخلافا لبعض الأشعرية في قولهم إنه عرض واحد مخالف لسائر الأعراض والعلوم"؛ ثم يستدل على صحة ذلك من داخل نظرية الجوهر الفرد فيقول: إن العقل لو كان جسما أو جوهرا "لوجب أن تكون سائر الجواهر والأجسام عقلا لأن الجواهر كلها من جنس واحد، فلو كان بعضها عقلا لكان سائرها كذلك".
العقل إذن عرض، ولكنه ليس عرضا واحدا بعينه، كما يقول بعض الأشاعرة، بل هو جملة أعراض. وهذه الجملة من الأعراض ليست من أجناس الأعراض المخالفة للعلوم (للمدركات) كاللون والرائحة والطعم والحرارة والبرودة إلخ، لأنه لا شيء منها "إلا وقد يوجد بالحي ولا يكون بذلك عاقلا. فثبت أنه مخالف لسائر الأعراض سوى العلوم. ولا يجوز أن يقال إن العقل هو الحياة لأن العقل يبطل ويزول، ولا يخرج الحي عن كونه حيا، وقد يكون الحي حيا وإن لم يكن عالما بشيء أصلا. ولا يجوز أن يقال إن العقل -هو- جميع العلوم الضرورية والكسبية لأن العقل يصح وجوده مع عدم جميع العلوم النظرية، ولا يجوز أن يكون هو جميع العلوم الضرورية لأن ذلك يؤدي إلى أن الأكمه والأخرس والأطرش ليسوا بعقلاء لأنهم (الأخرس إلخ) يعلمون المشاهدات والمسموعات والمدركات، التي تعلم باضطرار - يعلمونها بالاستدلال".
ومع كل هذه الاحتياطات "الحنبلية" فقد كان هناك من الأشاعرة من رأى أن القول إن العقل هو "بعض العلوم الضرورية" مدعاة للالتباس: التباس التصور البياني للعقل بتصور الفلاسفة، لأن عبارة "بعض العلوم الضرورية"، قد توحي بالاعتقاد في "الضرورة العقلية" التي يقول بها الفلاسفة والتي تتنافى مع نظرية الجوهر الفرد وبالتالي مع الرؤية البيانية "العالمة" القائمة على رفض السببية والقول بدلها بـ "العادة". وتجنبا للالتباس يعمد هؤلاء إلى المطابقة بين "العلم" و"العقل"، استنادا على الاستعمال اللغوي. واللغة كما نعرف هي السلطة المرجعية الأولى والأخيرة في النظام المعرفي البياني.
يقول أبو بكر ابن العربي، الفقيه الأشعري المتشدد، في سياق رده على القائلين إن العقل قادر على التوصل إلى معرفة الله بنفسه وأنه لا حاجة في ذلك إلى شرع، يقول: "هذه طائفة لم تعلم العقل ولا عقلته، وأفرادها مختلفون فيما بينهم حول معناه: "وهم يقولون إنه مشترك (يدل على معان متعددة مختلفة)، من معانيه صحة النظر، ومنها التجربة، ومنها الوقار والسكينة، وزادوا على إخوانهم الفلاسفة أنه علوم ضرورية وعلوم نظرية، وعملي وهيولاني (مادي) وملكي (=بالملكة) وفعلي (=بالفعل)، ومستفاد وفعّال". ثم يضيف متسائلا: "فما ظنك بمعلوم بيِّن يدخل في الإشكال في هذه السوق الكاسدة ويباع البيوعات الفاسدة"؟ ويضيف ابن العربي: "العقل في لسان العرب: العلم. لا فرق عندهم بين عقلت وعرفت وعلمت والخلق كما قال الله عز وجل "والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا" (النحل 78)، ثم يخلق لهم العلم، العقل، المعرفة، التمييز، الإدراك، التفطن، الذكر إلى آخر الخطط والأسماء، رتبة بعد رتبة وشيئا بعد شيء، وليس فيه استعداد لذلك من عند الله فيه إلا ما ينشئه له كما ينشئه في الشجر والحجر وطرف الظفر والأنملة، لا يختص ببنية ولا يلزم بحالة، فإن جرى شيء من ذلك على صنعته فهي عادة لا علة، وحالة عارضة، باتفاق، من صنع الله وإرادته، لا واجبة في مخلوقاته، ويخلق له علما مركبا على علم يجده، مساويا في ثمرته وإفادته فيكون تجربة، فإن ظهر على أقواله وأفعاله كان منتفعا له… فأما القول إنه علوم ضرورية فإنما تعلق به المتكلمون من علمائنا لأنهم رأوا أنه لا يبتلي الله بأوامره ونواهيه إلا من جعل فيه مقدمات من علومه، فتلك المقدمات، لما سماها الله عقلا، ظنوا أنه كل العقل. ولا يلزم ذلك، لأن الله قد سماها علما فقال: "إن في ذلك لآية لقوم يعلمون" (النمل 52)، كما قال: "إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون" (البقرة 164).
ها نحن إذن نعود إلى نقطة البداية، النقطة التي انطلقنا منها: العقل هو العلم، ولا شيء غير ذلك!
لماذا هذه العودة إلى الأصل اللغوي؟ إنه لا معنى لتفسير ذلك بتشدد ابن العربي وانغلاقه وعدم تفتحه، فلقد كان هناك قبله من كانوا أكثر منه تشددا كالحنابلة وغيرهم، ومع ذلك قبلوا تعريفات للعقل تخرج به عن القول إنه مجرد العلم لا أكثر. ولا يمكن أن يعزى ذلك إلى تقيد ابن العربي بحرفية النص في الآيات المذكورة، فالآيات التي استشهد بها لا تنص هي ولا غيرها على أن القرآن يقيم مطابقة بين العقل والعلم. فلفظ "العقل"، - هكذا بصيغة الاسم- لم يرد في القرآن قط، وإنما وردت فيه ألفاظ من مادة (ع. ق. ل) بصيغة الفعل الماضي والفعل المضارع (عقلوه، تعقلون، نعقل، يعقلها، يعقلون) لا غير. هذا فضلا عن أن آيات أخرى تقيم نوعا من التمييز بين العقل والعلم كالآية التي تقول: "وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون"، (العنكبوت 43).
وإذن فليست النزعة النصية هي التي دفعت ابن العربي الأشعري إلى العودة مجددا إلى المطابقة بين "العلم" و"العقل"، معرضا عن جميع التعريفات الأخرى، حتى تلك التي قال بها زملاؤه في المذهب. إن الأمر يتعلق، في اعتقادنا، باستعادة النظام المعرفي البياني لتوازنه الذاتي. لقد رأينا كيف رفض البيانيون، معتزلة وأشعرية، فكرة "الطبع" ومفهوم "المزاج" حتى عندما ربطوا العقل بالقلب فقالوا، بدلا عن ذلك، بأن المقصود بالقلب عندما يطلق ويراد به العقل ليس مزاج القلب، بل القلب بوصفه بنية مخصوصة، أي جملة من المعارف تقوم به. وعندما أرادوا تعيين هذه المعارف وقبلوا عبارة "العلوم الضرورية" جاء ابن العربي لينبه إلى أن هذه العبارة قد تفيد أن العقل بنية ثابتة أو جملة مبادئ ثابتة، الشيء الذي يتنافى ويتناقض مع مبدأ التجويز البياني. لذلك نجده يلح على القول إن العقل "لا يختص ببنية ولا يلزم بحالة"، ثم يضيف: "فإن جرى شيء من ذلك على صفته فهي عادة لا علة، وحالة عارضة باتفاق، من صنع الله وإرادته لا واجبة في مخلوقاته". ومعنى هذا أن تعريف "العقل" يجب أن يحترم مبدأ التجويز، أو مبدأ اللاسببية، وبالتالي يجب ألا يتضمن بصورة من الصور فكرة "الضرورة العقلية".
وإذا كان الأمر كذلك فكيف نفسر قبول الأشاعرة تعريف العقل بأنه "بعض العلوم الضرورية"؟ وبعبارة أخرى ما معنى الضرورة في اصطلاحهم؟
ذلك ما سنجيب عنه في المقال القادم التي سنتناول فيها مفهوم المعرفة وأصنافها عندهم.