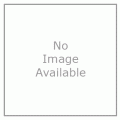أهي ذروة الوحدة الأطلسية؟
استفادت أوروبا من لحظة غير عادية من الوحدة عبر الأطلسي على مدار العام الأخير. فقد استجابت الشراكة الأمريكية الأوروبية بسلاسة للحرب الروسية الأوكرانية من خلال فرض عقوبات منسقة، مع استشارة الولايات المتحدة للحكومات الأوروبية قبل ملاحقة أي محادثات حول مستقبل الأمن الأوروبي مع الكرملين. أما حلف شمال الأطلسي "الناتو"، التحالف الذي عده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 2019 "ميتا دماغيا"، فإنه يزدهر الآن ويستعد للترحيب بفنلندا والسويد كعضوين جديدين. وأخيرا، يـنـفـق الأوروبيون قدرا أكبر من الأموال على الدفاع، حتى ألمانيا بلغت الهدف الذي طالما وعدت به، الذي يتمثل في تخصيص 2 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع.
يتفق الأمريكيون والأوروبيون في عموم الأمر أيضا على التحديات الاستراتيجية التي تفرضها الصين، خاصة الآن بعد أن نجح الرئيس الصيني شي جين بينج في توسيع سلطته وتوطيدها. وفي الغرب يسود شعور قوي بأن "الغرب قد عاد". إذ تعمل الولايات المتحدة وأوروبا على توجيه الوحدة السياسية المكتشفة حديثا لدعم القيم المشتركة والرؤية المشتركة للهيئة التي يريدان العالم عليها.
لكن سحب العاصفة تتجمع بالفعل. في الأمد القريب، ربما يحاول مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مقاومة فكرة أن أمريكا يجب أن تغطي جزءا كبيرا بشكل غير متناسب من تكاليف الدفاع عن أوكرانيا. كما يلاحظ زميلي في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية جيريمي شابيرو، في تعليق حديث، تعهدت الولايات المتحدة بتقديم 24 مليار دولار في هيئة مساعدات عسكرية لأوكرانيا، في حين التزمت أوروبا بنصف هذا المبلغ فقط. لماذا يدفع الأمريكيون أكثر من جيران أوكرانيا أنفسهم؟
علاوة على ذلك، في الأمد الأبعد، قد تتسبب المناقشات حول كيفية تعريف الانتصار الأوكراني في توترات جديدة. فبينما تشير إدارات بايدن وفرنسا وألمانيا إلى ضرورة إجراء مفاوضات سلام عند مرحلة ما، أوضحت بولندا ودول البلطيق أنها تريد أن ترى روسيا متواضعة ومهزومة. من ناحية أخرى، رشح ترمب نفسه للتوسط في اتفاق بين روسيا وأوكرانيا.
لا يخلو الأمر أيضا من توترات تختمر تحت السطح عندما يتعلق الأمر بالصين. ففي حين يتحرك جميع الحلفاء عبر الأطلسي في الاتجاه ذاته، فإن هذا لا يعني أنهم يقصدون الوجهة نفسها. على سبيل المثال، قام المستشار الألماني أولاف شولتز، بزيارة إلى بكين، حيث أظهر قدرا ضئيلا من الاهتمام بالفصل بين الاقتصادات الأوروبية والاقتصاد الصيني "رغم أنه يدرك تمام الإدراك مخاطر الاتكالية المفرطة".
تملك الفزع من الأوروبيين إزاء اعتبارات الحماية التي يقوم عليها قانون الشرائح والعلوم الأمريكي، وقانون خفض التضخم، والقرار الذي اتخذته وزارة التجارة بتقييد التعاون في قطاعات التكنولوجيا الفائقة. الواقع أن قانون خفض التضخم يغلق سوق المركبات الكهربائية الأمريكية حتى أمام شركات من حلفاء مثل أوروبا، واليابان، وكوريا الجنوبية. والأوروبيون محقون في الشعور بالقلق والانزعاج من أن يتحولوا إلى أضرار جانبية في الحرب الاقتصادية التي تشنها أمريكا على الصين، ومع ذلك يدعون إلى تقديم الدعم الدبلوماسي فيما يتصل بقضية تايوان.
لكن أكبر المخاطر لا تزال تأتي من السياسة الداخلية الأمريكية. تساءل عديد من المعلقين حول ما إذا كان أداء الجمهوريين الضعيف نسبيا في انتخابات التجديد النصفي يشير إلى نهاية سيطرة ترمب على الحزب. لم يقتصر الأمر على فشل عديد من المرشحين الذين دعمهم ترمب، بل إن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، وهو أحد أبرز المتنافسين على ترشيح الحزب الجمهوري لمنصب الرئاسة في 2024، فاز بإعادة انتخابه بأغلبية ساحقة.
يتمتع ديسانتيس بقدر كبير من الشعبية، لكنه إذا تحدى ترمب فقد ينتهي به المطاف إلى ملاقاة المصير ذاته الذي لاقاه جيب بوش والآخرون الذين رفضهم الناخبون الجمهوريون في الانتخابات التمهيدية في 2016. الأمر الأكثر أهمية أن مذهب ترمب لم يمت. سيتسمر المرشحون الجمهوريون في خوض حروب تتغذى على ثقافة الأرض المحروقة واحتضان مواقف مماثلة لمواقف ترمب ضد التجارة الحرة، والهجرة، والتدخل الأجنبي، وأوروبا. ونظرا إلى حالة الاقتصاد العالمي المتدهورة، فقد تكون الظروف مواتية للجمهوريين لتقديم أداء أفضل في الانتخابات المقبلة، خاصة إذا تعلموا من أخطائهم في 2022.
لكل هذه الأسباب، يتعين على الأوروبيين أن يستغلوا العامين المقبلين للحد من اعتمادهم على الولايات المتحدة. وإذا خاض بايدن الانتخابات مرة أخرى وفاز، فستكون أوروبا الأكثر اعتمادا على الذات قادرة على العمل كشريك أفضل كثيرا للولايات المتحدة. أما إذا تم انتخاب ترمب أو شخصية أخرى من المشككين في أوروبا، فسيكون الأوروبيون على الأقل في وضع أفضل لتحمل العاصفة. مع تبقي عامين فقط لإقامة دفاعات فاعلة ضد أي "موجة حمراء" في المستقبل، فإن الوقت حان لكي يبادر الأوروبيون إلى بناء جدارهم بالطريقة التي تناسبهم.
خاص بـ «الاقتصادية»
بروجيكت سنديكيت، 2022.