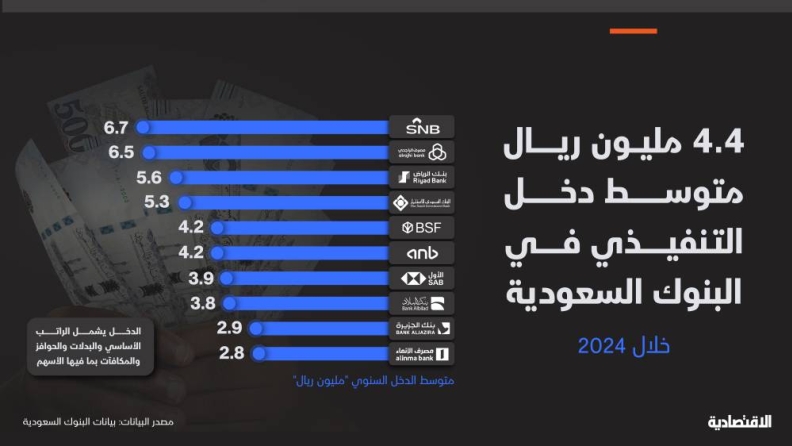الأسواق قديما .. كيف شكلت ملامح الاقتصاد في الدولة السعودية الأولى؟
مع احتفال السعوديين اليوم بذكرى التأسيس، يُستحضر التاريخ بجميع تفاصيله، ومن أبرز جوانبه، الاقتصاد، الذي شكّل جزءًا أساسيًا من ملامح الدولة السعودية منذ نشأتها قبل نحو 3 قرون.
كيف كانت حركة التجارة؟ وعلى ماذا كانت تعتمد السوق؟ وما العملات التي تداولها التجار؟ لم تكن الدرعية مجرد عاصمة سياسية للدولة السعودية الأولى، بل مركزًا اقتصاديًا يعتمد على الاستيراد والتصدير.
فمع تأمين الطرق واستقرار الأمن بعد تولي الإمام محمد بن سعود إمارة الدرعية عام 1727 ازدهرت الأسواق في الدولة، ما شجع التجار على تصدير السلع مثل السمن، القمح، التمور، والصوف إلى الشام، العراق، مصر، واليمن، وغيرها، واستيراد الأقمشة، والمنسوجات، العطور، الأدوات المنزلية، القهوة، وحتى المنتجات الجديدة مثل الكبريت والمصابيح، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" الدكتورعبد المحسن الرشودي رئيس قسم التاريخ والحضارة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
في سوق الدرعية، كانت تصطف الدكاكين والبسط المفروشة على الأرض، وتعج الشوارع الواسعة بصوت الباعة والمشترين الذي وصفه المؤرخ ابن بشر بـ"نجناج"، وهو الصوت غير المميز في الأماكن المزدحمة.
لم تكن السوق مجرد مكان للبيع والشراء، بل كانت جزءا من الحياة اليومية للسعوديين، لتبادل الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة أسعار السلع في مختلف الدول.
قبل أن يصبح الريال السعودي العملة الرسمية كان التجار يتعاملون بالمقايضة ومبادلة السلع فمثلا، كان تاجر الأقمشة أو الملابس يبادل الفلاح بجزء من محصول التمر عندما يحين موسم الحصاد، أو مبادلة حبوب القمح مقابل السمن والصوف.
بحسب الرشودي، فإنه في عهد الدولة السعودية الأولى والثانية، كان الأغلب يعتمد على المقايضة إلى عهد الملك عبدالعزيز، حيث بدأ الناس يستخدمون الأموال النقدية بشكل أكبر بعد اكتشاف النفط في عام 1938، عندما بدأت الحكومة في صرف الرواتب، وبدأت تتوافر السيولة، فأصبح البيع والشراء بالمال النقدي شائعا، قبل ذلك، لم يكن التعامل بالعملات معدومًا، لكنه لم يكن منتشرا مثل المقايضة.
وكانت تتداول عملات متنوعة مثل الريال الفرنسي (ريال ماريا تريزا) وعملة تسمى بالطويلة مصنوعة من الفضة، وعملات أخرى إلى الروبية الهندية والجنية الإنجليزي إلى أن تم سك الريال العربي على يد الملك عبدالعزيز.
واشتهرت الدولة السعودية الأولى بأسواقها العامرة في نجد، الحجاز، تهامة، الإحساء، وعسير، وكانت التجارة من أبرز المهن إلى جانب الزراعة والفلاحة، كانت بعض الأسواق تُعقد بانتظام، بعضها أسبوعيًا، وبعضها شهريًا أو سنويًا، وكان يطلق على السوق التي تعقد في الدرعية "المَوسِم" وهي لهجة محلية تعني موضع البيع والشراء.
ومن أقدم الأسواق التقليدية، سوق عكاظ الذي يعود تاريخه إلى ما قبل الإسلام، حيث كان مركزًا للتجارة والأدب والمنافسات الشعرية.
وبعد تأمين الطرق التجارية، توسع التجار في تصدير سلعهم واستيراد السلع التي يحتاجها السوق المحلي، دون خوف من السرقة أو السطو، وبدأوا أيضًا بجلب بعض المنتجات الأوروبية، ليس بشكل مباشر، بل عبر دمشق، حيث كانت تعد محطة لوصول البضائع الأوروبية. واعتمد التجار على الإبل لنقل بضائعهم إلى الأسواق في الشام، العراق، والسودان، واليمن إضافة إلى الهند.
وكان للهند دور محوري في التجارة، إذ استوطنت بعض الأسر النجدية هناك وأقامت مكاتب تجارية، كما استُوردت بضائع متنوعة، منها الأثاث كـ"السحارة" التي كانت بمنزلة دولاب الملابس أو جهاز العروسة، إضافة إلى الطواحين اليدوية للقهوة، التوابل، ووصلت هذه السلع إلى نجد عبر الخليج العربي، مرورًا بالكويت والبحرين، أو عبر الأحساء، ما جعل المنطقة جزءًا من شبكة تجارية مترابطة تربطها بمختلف الأسواق الإقليمية والدولية، حسبما ذكر الرشودي.
اعتمد التجار على قوافل الإبل لحمل البضائع ونقلها، بينما بعض التجار كانوا يركزون على تصدير المواشي فقط، حيث كانوا يسافرون بمئات الإبل ويبيعونها دفعة واحدة، وغالبًا ما تتم هذه العمليات بالشراكة بين عدة تجار يساهمون برؤوس الأموال، فيما يتولى شخص منهم إدارة العمليات الشرائية وتجميع الإبل من القبائل استعدادا للرحلة التجارية.
وكان يُكلَّف بعضهم بعد بيع الإبل، بشراء بضائع معينة وإعادتها إلى الأسواق المحلية، مثل الدلال والأباريق التي كانت تصنع في العراق والشام، إضافة إلى المنتجات الجديدة التي بدأت تصل إلى الأسواق في ذلك الوقت، مثل الكبريت، والمصابيح والسرج ، ما جعل التجارة نظامًا اقتصاديًا متكاملًا يربط نجد بالمراكز التجارية في المنطقة.
لم تكن التجارة مجرد عملية بيع وشراء، بل كانت نظامًا اقتصاديًا متكاملًا يربط نجد بالمراكز التجارية في المنطقة، ويعكس ازدهار النشاط الاقتصادي في الدولة السعودية الأولى، وهو ما يظل جزءًا من ذاكرة تأسيس الدولة وركيزة من ركائز تطورها.