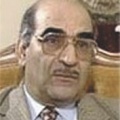رسائل إخوان الصفا والدعوة إلى دين عالمي واحد!
أوضحنا في المقال قبل الأخير كيف تصدى المعتزلة للدفاع عن الإسلام ضد ''أهل الملل والنحل''، ممن هاجم الإسلام من خارجه. ثم شرعنا في المقال السابق في التعريف بفرق أخرى ''مغالية'' لبست لباس الإسلام لتمطيطه من الداخل وإفقار مضمونه عقيدة وشريعة... يتعلق الأمر بصنف آخر من ''الغلاة''، قاموا بتأسيس طموحة، جعلت استراتيجيتها العامة الدعوة إلى دين عالمي واحد للناس جميعا! وقد أطلق مؤرخو الفرق عليها عدة أسماء (السبعية، الإسماعيلية، الباطنية، والتعليمية: أي القائلة بضرورة معلم إمام)، فلهؤلاء سنخصص هذا المقال، ليس بالقصد الأول، بل من أجل بيان ''السبب'' في لجوء المأمون العباسي إلى ترجمة فلسفة أرسطو ومنطقه مما كانت نتيجته: أولا، ظهور أول فيلسوف عربي دافع عن مبادئ الإسلام ضد الباطنية (الكندي 185 - 252 هـ) من جهة، وإلحاح الغزالي، ثانيا وفيما بعد، على تعلم المنطق الصوري الأرسطي، إلحاحا جعله يقرر في مقدمة كتابه ''المستصفى في أصول الفقه'' أن من لا يعرفه ''لا يوثق بعلومه أصلا''.
واضح أن ما يجمع هنا بين المأمون والكندي وبين نظام الملك السلجوقي والغزالي هو التصدي للحركة الباطنية ''التعليمية''، التي سنتعرف، أولا وبإيجاز، على ظروف نشأتها وطبيعة أهدافها.
أشرنا في المقال السابق إلى ''تسرب'' عناصر وشظايا من الفلسفة الدينية الهرمسية إلى المجتمع العربي الإسلامي منذ أواخر العهد الأموي، و قلنا إن عملية التسرب هذه قد اتسعت في العصر العباسي الأول، حتى صارت تشكل إيديولوجية دينية سياسية معارضة، تغذي تنظيماتها السرية بواسطة رسائل دورية تتناول بالشرح والتبسيط مجمل الفلسفة الدينية الهرمسية بعلومها المختلفة الشرعية منها والعقلية، العلنية منها والسرية؛ رسائل أطلق عليها أصحابها (أعني إيديولوجيو الحركة الإسماعيلية) اسم ''رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا'' (بلغ عددها 52 رسالة في أربعة مجلدات من القطع الكبير، ثم أضيفت إليها رسالة ''الجامعة'' ثم ''جامعة الجامعة'').
بين أيدينا شهادات تؤكد أن تأليفها بدأ بعد تطور الفرقة الخطابية التي أشرنا إليها في المقال السابق، وتحولها إلى ''فرقة إسماعيلية''. ذلك أن أبا الخطاب، مؤسس هذه الفرقة، كان ملازما لإسماعيل بن جعفر الصادق (حتى بعد أن تبرأ منه هذا الأخير لغلوه)، وكان صلة الوصل بينه (أعني إسماعيل) وبين الغلاة يخدمه خدمة الأستاذ للتلميذ! وإلى جانب أبي الخطاب هذا كان هناك ميمون القداح الذي يقال عنه إنه كان مولى للإمام جعفر الصادق، وأنه كان يقوم هو الآخر على خدمة ابنه إسماعيل الذي يقال إن والده قد نص عليه إماما من بعده. لكنه، أعني إسماعيل، توفي في حياة والده ثم توفي جعفر نفسه بعد ذلك، فبادر ميمون القداح إلى تكوين فرقة جديدة تدعو إلى مهدية إسماعيل. ثم لما شب محمد، ابن هذا الأخير (؟)، صرف ميمون القداح الدعوة إليه. ولما مات ميمون القداح قام بالدعوة من بعده ابنه عبد الله الذي سار بالحركة إلى نهايتها.. إلى قيام الدولة العبيدية، الفاطمية. ولا بد من الإشارة كذلك إلى حركة حمدان قرمط مؤسس فرقة القرامطة. يقول البغدادي : ''وظهرت دعوة الباطنية، في أيام المأمون، من حمدان قرمط، ومن عبد الله بن ميمون القداح''.
وتؤكد المصادر التاريخية الإسماعيلية ذلك، وأقدمها القاضي النعمان بن حيون المغربي التميمي قاضي القضاة في الدولة الفاطمية المتوفى سنة 363 هـ، فهو يذكر في كتابه ''الرسالة المذهبة'' (ص 72) ''أن مؤلفي رسائل إخوان الصفا، هم عبد الله بن حمدان، وعبد الله بن سعيد، وعبد الله بن ميمون، وعبد الله بن المبارك... ''.
وواضح أن هذه النصوص تتجاوز ما ذكره أبو حيان التوحيدي في كتابه ''الإمتاع والمؤانسة''، من كون رسائل إخوان الصفا كانت من تأليف جماعة من كتاب عصره حوالي سنة 373 هـ. والواقع أن الذين ذكرهم التوحيدي كانوا من أتباع الحركة الإسماعيلية في ''دور الستر'' يتداولون رسائل إخوان الصفا ولم يكونوا من مؤلفيها. يركد هذا من الناحية التاريخية أن عبد الله بن ميمون الذي تنسب إليه الروايات الإسماعيلية البدء في تأليف رسائل الإخوان قد توفي سنة 212 هـ وأن ابنه أحمد الذي تعتبره نفس الروايات المشرف الفعلي على إتمام تأليفها قد توفي حوالي سنة 229 هـ. وهذان التاريخان يؤكدان أن رسائل إخوان الصفا قد جاءت فعلا كرد من التنظيم الباطني الإسماعيلي على استراتيجية المأمون الثقافية، تلك الاستراتيجية التي استهدفت مقاومة الأطروحات الباطنية الغنوصية بأطروحات عقلية تعتمد علوم أرسطو ومنطقه بكيفية خاصة.
لقد تبين أن المنهج الذي استعمله المعتزلة (قياس الغائب على الشاهد) في الدفاع عن الإسلام ضد الهجوم الذي تعرض له من ''الخارج''، من طرف ''أهل الملل والنحل''، لا ينفع مع هؤلاء الباطنية الذين يلبسون لباس الإسلام ويحاولون إعطاءه مضمونا يخترق حدود البياني العربي بالتمييز في نصوص بين ''الظاهر'' و''الباطن''. إنه العرفان (الغنوص) الذي لا يمكن مقاومته إلا بالمنطق (الأرسطي). وذلك ما كانت قد فعلته المسيحية قبل ظهور الإسلام، عندما تعرضت لهجمة غنوصية حادة. كانت ''رسائل إخوان الصفا'' تدعو إلى ''دين عالمي واحد'' منسجم، يخلو من أي اختلاف؛ وهي تقرر أن الاختلاف بين المتكلمين في مناظراتهم وعدم اتفاق ''المتفلسفين والشرعيين (الفقهاء) جميعا'' ووقوعهم في ''منازعات ومناقضات''، راجع إلى أنه ''لم يكن لهم أصل واحد صحيح، ولا قياس واحد ... بل كانت أصولهم مختلفة وقياساتهم متفاوتة غير مستوية''، وبالتالي لم يكن هدفهم طلب الحقيقة، كلا؛ بل هم : ''الدجالون الذلقو الألسن، العميان القلوب، الشاكون في الحقائق، الضالون عن الصواب''. أما منطق الفلاسفة فإنما يحتاج إليه من الناس أولئك الذين لا تزال نفوسهم مغمورة في الأجساد: ''أما النفوس الصافية غير المتجسدة فهي غير محتاجة إلى الكلام والأقاويل في إفهام بعضها بعضا العلومَ والمعاني التي في الأفكار (ربما يعنون ''مثل'' أفلاطون) وهي النفوس الفلكية، لأنها (أي النفوس الصافية) قد صفت من درن الشهوات الجسمانية (…)، فاجتهد يا أخي، فلعل نفسك تصفو وهمتك تعلو من الرغبة في هذه الدنيا الدنية لتصير كالنفوس الفلكية''... وغني عن القول إن هذه الدعوة ومثيلاتها كانت في ''دور الستر''، دور العمل السري لكسب الأتباع.
أما المبدأ الذي تؤكده رسائل ''الإخوان'' وتقول عنه إنه وحده مفتاح الحقائق كلها وإنه وحده يحقق الوحدة الفكرية بين الناس، فهو ذلك المبدأ الهرمسي المعروف، مبدأ تشبيه العالم بالإنسان: فالعالم ''إنسان كبير'' لأنه ''جسم واحد بجميع أفلاكه وأطباق سماواته (…) وله نفس واحدة (النفس الكلية) سارية قواها في جميع أجزاء جسمه سريان نفس الإنسان الواحد في جميع أجزاء جسده''. والإنسان بدوره ''عالَم صغير'' لأنه ''جملة مجموعة من جسد جسماني ونفس روحانية... في هيئةِ بنيةِ جسده مثالاتٌ لجميع الموجودات التي في العالم الجسماني، من عجائب تركيب أفلاكه وأقسام أبراجه وحركات كواكبه''. أما نفسه فلها شبه ''بأصناف الخلائق الروحانيين من الملائكة والجن''.
ليس هذا وحسب، فالتطابق الذي تقيمه رسائل إخوان الصفا بين الإنسان والعالم تقيمه أيضا بينهما وبين المجتمع أو الدولة – وهذا بيت القصيد! وهكذا فكما أن العالم تسيره وتسري فيه نفس كلية مثلما تسري نفس الإنسان في جسده، فكذلك المجتمع والدولة يجب أن تسري فيهما وتسيرهما نفس ''نبوية''، أي إمام من سلالة النبي يساعده دعاة ذوو درجات متراتبة على مثال تراتب الروحانيين، أي الملائكة.
مثل هذه الآراء التي تنظر إلى الكون والإنسان والألوهية بمثل هذه ''النظرة الشمولية المغالية'' لن ينفع معها منهج المتكلمين والفقهاء والبلاغيين الذي يقوم في أساسه على اعتبار ''علاقة المشابهة'' بين جزء وجزء، (بين النبيذ والخمر مثلا)، ذلك لأن الشاهد والغائب متماثلان في هذه النظرة، والمنهج الذي تعتمده هو المماثلة (analogy-ie) القائمة على اعتبار ''التشابه في العلاقة'' (النبيذ بالنسبة للخمر كالبلح بالنسبة للتمر، ونفس الإنسان بالنسبة لبدنه كالنفس الكلية بالنسبة لجرم العالم)!
ومن هنا كان من الضروري اعتماد منهج آخر قادر على احتواء المماثلة (أو التمثيل) ووضعها في مكانها الحقيقي كأدنى درجات سلم الصحة والصدق؛ هذا المنهج – كان في ذلك الزمان- هو القياس الصوري المنطقي الأرسطي.