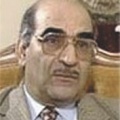الفارابي والملة الفاضلة ...
عالج الفارابي مشكلة إعادة الوحدة للمجتمع، وهو يفكر في المجتمع الإسلامي، من زاوية تختلف عن تلك التي نظر منها كل من أفلاطون وأرسطو إلى المشكلة نفسها عند اليونان. معلوم أن أفلاطون نظر إلى المشكلة من زاوية البحث عن وسيلة لإقرار «العدل» (بمعنى انتفاء الظلم بإنزال الناس منازلهم) فانتهى إلى نتيجتين: الأولى أن «العدل» في المجتمع لا يمكن أن يتحقق دون دولة تدبر شؤونه، الثانية أن الدولة التي من شأنها أن تحقق العدل هي «المدينة الفاضلة»: أي «الدولة/المدينة» التي يرأسها «حكيم» (فيلسوف) يكون، بالطبع وبالتربية معا، مهيأ لهذه المهمة. وقد أكد أفلاطون على هذا الشرط تأكيدا خاصا فقال : «إنه ما دام الفلاسفة ليسوا حكاما، وما دام الحكام غير فلاسفة فلا سبيل لإقامة العدل». لكن أفلاطون اعترف في النهاية أنه ليس بالإمكان تحقيق المدينة الفاضلة في «الحياة الدنيا» لأن الفلاسفة قليلون وإذا وجدوا فإن الناس لا يريدون تنصيبهم حكاما عليهم. وبالتالي فمكان المدينة الفاضلة هو عالم السماء، عالم «المثل»، عالم الموجودات الكاملة.
ولكي يتفادى أرسطو هذه النهاية السلبية نظر إلى المدينة «المدينة الفاضلة» من زاوية أخرى، زاوية «الأخلاق والسياسة» (تدبير النفس وتدبير المدينة). ذلك لأن الإنسان «مدني بالطبع»، لا يعيش بمفرده بل في «مدينة» وبالتالي فإن إقرار العدل يتطلب دستورا عادلا وقوانين عادلة، وإذن فلكي تكون المدينة فاضلة لابد لها من دستور عادل وقوانين تشرع لإقامة العدل.
وعند أرسطو أنه إذا خُير الناس بين رجل فاضل كالفيلسوف (رئيس مدينة أفلاطون) وبين الدستور والقوانين العادلة فإن عليهم أن يختاروا الدستور والقوانين العادلة لأنها لا تتغير من ذاتها، أما الرئيس الفاضل فلا شيء يضمن ألا يتغير هو أو خلَفُه، فيؤول الأمر إلى الاستبداد...
يعرض الفارابي آراء أفلاطون وأرسطو متداخلة (كما انتقلت إلى المجتمع الإسلامي من عصر الأفلاطونية المحدثة)، بعرضها في كتابين هما: «مبادئ آراء أهل المدينة الفاضلة»، وكتاب «السياسية المدنية»، دون تدخل أو تعليق. لكنه عندما يفكر في التجربة التاريخية للمجتمع الإسلامي إلى عهده ينفصل عنهما (عن أفلاطون وأرسطو) ليفكر، من منظور إسلامي خالص، في المدينة الفاضلة الإسلامية التي يسميها «الملة الفاضلة». وفيما يلي أهم النقط التي ينفصل فيها عن «المدينة الفاضلة» اليونانية:
1- المدينة الفاضلة لا تنشأ من تلقاء نفسها، وإنما ينشئها رئيس أول : «»رئيس المدينة ينبغي أن يكون هو أولا، ثم يكون هو السبب في أن تحصل المدينة وأجزاؤها (...) الرئيس الأول هو الذي يرتب الطوائف وكل إنسان من كل طائفة في المرتبة التي هي استئهاله، وذلك إما رتبة خدمة وإما رتبة رئاسة (وذلك هو العدل : إنزال الناس منازلهم) … فتكون المدينة حينئذ مرتبطة أجزاؤها بعضها ببعض ومؤتلفة بعضها مع بعض، ومُرَتَّبة بتقديم بعض وتأخير بعض. وتصير شبيهة بالموجودات الطبيعية، ومراتبُها شبيهة أيضا بمراتب الموجودات التي تبتدئ من الأول (الإله) وتنتهي إلى المادة الأولى والأسطقسات» (العناصر الأربعة وهي أدنى المخلوقات). وهذا الرئيس الأول المؤسس للمدينة الفاضلة قد يكون هو «الفيلسوف» كما في التجربة اليونانية، وقد يكون «النبي» كما في التجربة الإسلامية.
2- معلوم أن اليونان بنوا مدينتهم الإلهية على غرار مدينتهم البشرية فأضفوا على الآلهة طابعا بشريا (يفرحون، يغضبون إلخ). أما الفارابي فهو بالعكس من ذلك يبني مدينته البشرية على غرار «المدينة الإلهية» (عالم السماء) كما هو الحال عند المتكلمين الذي بنوا «الشاهد» (عالم البشرية) بالصورة التي يمكن قياس الغائب عليه (عالم الألوهية. مقالات سابقة).
3- والمسألة الأهم التي ينفصل فيها الفارابي عن الفكر اليوناني جملة، هو أنه يضع النبي منشئا ورئيسا أولا للملة الفاضلة، وليس الفيلسوف كما فعل أفلاطون. الرئيس الأول للملة الفاضلة هو النبي، وهو شخص بشري يوحى إليه من الله كيف يدبر شؤونها ويقيم فيها الشرائع والقوانين. إنه لا يكتسب النبوة بالتربية والتعليم والتعامل مع المجردات كما هو شأن الفيلسوف. كلا، إن النبي شخص مُعَدٌّ بالفطرة للنبوة، إنه ليس عالم منطق أو فلسفة بل هو يتمتع بقدرة فكرية فطرية، فائقة التخيل، بحيث تمكنه من تلقي الوحي من الله بواسطة «العقل الفعال» أو «العقل العاشر» (بلغة فلاسفة الأفلاطونية المحدثة، وهو عندهم المدبر لما تحت فلك القمر، وهو جبريل بالاصطلاح الديني في التوراة والإنجيل والقرآن).
4- هذا عن الرئيس الأول للملة الفاضلة، المنشئ لها المشرع لشؤونها بوحي من الله مُعلَن (خطاب) أو غير معلن (هداية). أما الرؤساء الثواني (الخلفاء) فلابد فيهم من شروط: بعضها يرجع إلى الفطرة وبعضها يرجع إلى الإرادة، وهي تكاد تتطابق مع شروط المتكلمين والفقهاء في الخليفة. وهكذا فمن جهة يجب أن تتوافر فيه بالفطرة الشروط التالية: «أن يكون تام الأعضاء سليم الجسم، جيد الفهم والتصور، جيد الحفظ، جيد الفطنة ذكيا، حسن العبارة ليس في لسانه عيب، محبا للتعليم غير شره على المأكول والمشروب والمنكوح، محبا للصدق وأهله، كبير النفس محبا للكرامة، غير مهتم بأعراض الدنيا كالمال، محبا للعدل بالطبع ومبغضا للجور بالطبع، قوي العزيمة». أما الشروط الراجعة إلى الإرادة فهي أن يكون «حكيما (يتصف بالحكمة التي هي ما ينشده الفيلسوف)، عالما، حافظا للشرائع والسنن والسير التي دبرها الرئيس الأول (النبي) للمدينة، محتذيا بأفعاله كلها حذو تلك بتمامها، له جودة استنباط فيما لا يُحفَظ عن السلف فيه شريعة، ويكون فيما يستنبطه من ذلك محتذيا حذو الأولين، وأن يكون له جودة روية وقوة استنباط لما سبيله أن يعرف في وقت من الأوقات ولم يترك حوله الأولون شيئا. وأن يكون له جودة إرشاد بالقول إلى شرائع الأولين، وأن يكون له جودة ثبات ببدنه في مباشرة أعمال الحرب».
وبما أن هذه الشروط قد يتعذر توافرها في شخص واحد، فإن الفارابي يقترح أن تكون الرئاسة، في هذه الحالة، بالتشارك، يقول: «فإذا لم يوجد إنسان واحد اجتمعت فيه هذه الشرائط ولكن وجد اثنان أحدهما حكيم والثاني فيه الشرائط الباقية، كانا هما رئيسين في هذه المدينة، فإذا تفرقت هذه في جماعة وكانت الحكمة في واحد» والصفات الأخرى موزعة على آخرين «وكانوا متلائمين كانوا هم الرؤساء الأفاضل. فمتى اتفق في وقت ما أن لم تكن فيها الحكمة وكانت فيها سائر الشرائط بقيت المدينة الفاضلة بلا ملك، وكان الرئيس القائم بأمر هذه المدينة ليس بملك، وكانت المدينة تعرض للهلاك. فإن لم يتفق أن يوجد حكيم تضاف الحكمة إليه لم تلبث المدينة بعد مدة أن تهلك».
وهذا الاقتراح الذي يدلي به الفارابي لم يقل به أحد من مفكري الإسلام حسب علمنا، بل إن الاتجاه السائد عند المتكلمين والفقهاء هو أن خليفة المسلمين لا يكون إلا واحدا، وليس من الضروري أن يكون دائما هو «الأفضل» بل جوزوا تولية «المفضول» مع وجود «الأفضل» مع خلافات بينهم، فإن الفارابي لا يقول بتعدد الرؤساء/الخلفاء في وقت واحد وزمن واحد، وإنما يقترح «التشارك» في الرئاسة، أي التخفيف من سلطة الحاكم الفرد بإدخال الشورى كجزء من الرئاسة. وهنا تكون الشورى ملزمة أصالة ولا يبقى مجال لفكرة أنها «معلمة» فقط.
هناك مسألة أخرى يثيرها الفارابي بصدد «الملة الفاضلة» التي ينشئها النبي في قوم لم تكن لديهم فلسفة من عند قرائحهم، فهؤلاء: «إذا نقلت إليهم الفلسفة من أمة أخرى، لم يؤمن أن يُضادوا الفلسفة ويعاندها ويطرحونها ... أما أهل الفلسفة فهم ... يتحرون أن لا يعاندوا الملة نفسها بل إنما يعاندون مَنْ في ظنهم أن الملة مضادة للفلسفة، ويجتهدون في أن يزيلوا عنهم هذا الظن بأن يلتمسوا تفهيمهم أن (الأمور)التي في ملتهم هي مثالات»، أي بيانات بواسطة ضرب الأمثال والتجوز في الكلام، وتلك هي سبيل البيان المناسب لتعليم الجمهور، لا سبيل البرهان. والبيان والبرهان في هذا المجال لا يتناقضان، تماما كما لا يتناقض العقل مع الوحي، لأن مصدرهما واحد، هو الله واهب العقل وواهب الوحي. وهذا التصور الذي يقرره الفارابي هنا موافق تماما لرأي أهل السنة (معتزلة وأشاعرة وسلفية)، هؤلاء الذين يؤكدون أنْ : «لا تعارض بين صريح المعقول وصحيح المنقول».