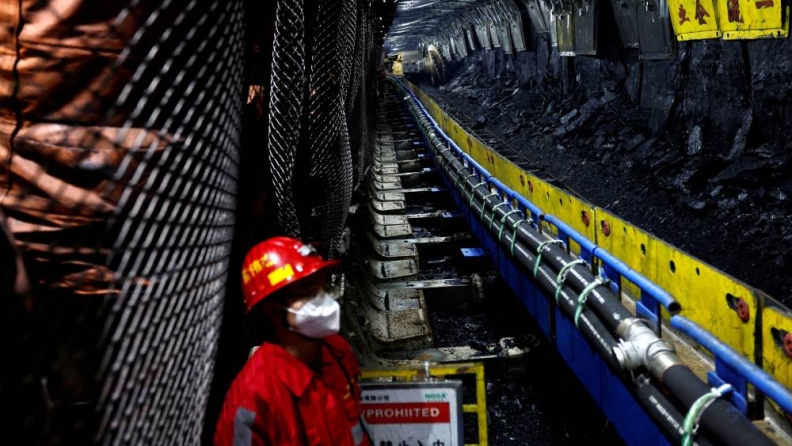بنهاية المطاف .. السعودية ستتسيد السوق البترولية وستخرج من الأزمة أقوى اقتصاديا وجيوسياسيا
مع بقاء أربعة مليارات شخص في أنحاء العالم، تحت ظروف منع التجول، في الوقت الذي يتزايد انتشار جائحة فيروس كورونا، يشهد الطلب على كل من البنزين ووقود الطائرات والمنتجات البترولية الأخرى انخفاضا شديدا، كما هي الحال مع أسعار البترول تماما. حيث انخفض سعر برميل الزيت الخام في الولايات المتحدة، إلى مستوى متدنٍ للغاية، اضطر معه البائعون، أخيرا، إلى دفع الأموال لمن يخلصهم من الكميات الموجودة لديهم.
ونتيجة لهذا، باتت الاقتصادات التي تعتمد على البترول غير مستقرة. ففي الولايات المتحدة، أكبر منتج للبترول في العالم؛ هبط عدد حفارات البترول 50 في المائة خلال شهرين فقط، ومن الممكن أن يواجه 40 في المائة من منتجي الزيت والغاز الإعسار المالي خلال هذا العام، ومن المتوقع أن يفقد نحو 220 ألفا من العاملين في قطاع البترول وظائفهم.
وفي بقية أنحاء العالم، تعاني الدول البترولية معاناة كبيرة، من نيجيريا إلى العراق وكازاخستان، مع الهبوط الحاد الذي تشهده عملاتها، فيما تقف بعض الدول، مثل فنزويلا، على حافة هاوية اقتصادية واجتماعية سحيقة.
وعلى الرغم من أن عام 2020 سيذكر باعتباره عام الأزمة الحقيقية بالنسبة إلى الدول البترولية؛ فإن دولة واحدة، على الأقل، من المرجح أن تخرج من أزمة وباء كورونا وهي تتمتع بقدر أكبر من القوة على الجانبين الاقتصادي والجيوسياسي؛ وهي: المملكة العربية السعودية.
أولا، برهنت السعودية على أن إمكاناتها المالية قادرة على مواجهة عاصفة مثل هذه. فأسعار البترول المتدنية تعد مؤلمة، بطبيعة الحال، لدولة تحتاج إلى نحو 80 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في موازنتها العامة، الأمر الذي دفع وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى خفض توقعاتها المالية لها يوم الجمعة الماضي. فقد شهدت السعودية عجزا في الموازنة بلغ تسعة مليارات دولار خلال الربع الأول من عام 2020. وككل الدول الأخرى، شهدت أيضا تراجعا في العائدات الضريبية، في ظل قيامها بفرض قيود اقتصادية لوقف انتشار الجائحة.
وفي الأسبوع الماضي، صرح وزير المالية السعودي بأن الإنفاق الحكومي يجب "تخفيضه بشدة"، وأن بعض أجزاء خطة تنويع الاقتصاد، في رؤية المملكة 2030، سيتم تأجيل تنفيذها.
ومع ذلك، فعلى النقيض من أغلبية منتجي البترول الآخرين، لا تمتلك السعودية احتياطيات مالية ضخمة فحسب، بل تمتلك أيضا قدرة واضحة على الاقتراض. فقد أعلن وزير المالية، في يوم 22 نيسان (أبريل)، أنه يمكن للمملكة أن تقترض مبلغا يصل إلى 58 مليار دولار في العام الجاري 2020.
ومقارنة بأغلبية الاقتصادات الأخرى، فإن معدل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، متدنية نسبيا، حيث بلغ 24 في المائة في نهاية عام 2019، على الرغم من أن هذا الرقم شهد تزايدا في الآونة الأخيرة.
كما قال وزير المالية، أيضا، إن المملكة قد تسحب مبلغا يصل إلى 32 مليار دولار من احتياطياتها المالية. ومع وجود مبلغ 474 مليار دولار، لدى البنك المركزي "مؤسسة النقد العربي السعودي"، كاحتياطي من النقد الأجنبي، تقف المملكة بارتياح فوق مستوى الاحتياطي، البالغ 300 مليار دولار، الذي يعده الكثيرون الحد الأدنى، من احتياطي النقد الأجنبي، المطلوب لحماية العملة الوطنية للدولة، ألا وهي الريال، المرتبطة بالدولار.
ثانيا، بمجرد أن تستقر الأسواق، سينتهي المطاف بأن يكون لدى المملكة عائدات بترولية أعلى، ونصيب أكبر من سوق البترول، وذلك بفضل تخفيضات الإنتاج وعمليات الإغلاق التي تسبب فيها الهبوط الاقتصادي العالمي.
وتضع الحال الراهنة من الكساد في سوق البترول القواعد اللازمة لانتعاش الأسعار لاحقا خلال الأعوام المقبلة، ولتزايد عائدات المملكة تبعا لذلك. وعلى الرغم من أن توقعات الطلب المستقبلي على البترول غير مؤكدة إلى حد كبير، إلا أننا، بمجرد أن ننظر إلى ما بعد الأزمة الراهنة، سنرى أن من المرجح أن ينمو الطلب بمعدل أسرع من معدل نمو العرض.
وتشير توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن الطلب العالمي على البترول سيعود إلى مستوياته، التي كان عليها قبل الجائحة، مع نهاية عام 2020. كما أن لدى وكالة الطاقة الدولية القدر نفسه من التفاؤل، حيث تتوقع بأن يكون الطلب، مع نهاية العام، منخفضا يراوح بين 2 و3 في المائة فقط، عن متوسط الطلب في عام 2019، الذي كان قد بلغ 100 مليون برميل يوميا.
وإذا استمرت الإجراءات المتخذة لاحتواء الفيروس لوقت أطول من المتوقع، أو في حال ظهور موجة ثانية من الفيروس، فسيستغرق تعافي الأسواق وقتا أطول، لكن معظم السيناريوهات لا تزال تتوقع تعافي الطلب في نهاية المطاف.
ومع أنه بإمكان التغيرات التي طرأت على نمط الحياة أن تؤدي إلى انخفاض الطلب المستقبلي على البترول، إلا أن البيانات تشير إلى أن المرء ينبغي أن يشك في التنبؤات التي تتوقع حدوث تحولات دائمة.
ففي الصين، على سبيل المثال، استعاد كل من السفر بالسيارات وشحن البضائع بالشاحنات معدلاتها التي كانت عليها خلال العام الماضي، تقريبا، على الرغم من أن السفر بالطائرات، الذي يمثل مع الشحن الجوي 8 في المائة من الطلب العالمي على البترول بقي منخفضا بشدة.
ويمكن للطلب على البترول أن يشهد انتعاشا فعليا إذا قرر عدد أكبر من الناس أن السيارات الخاصة تجعلهم يشعرون بالأمان بدرجة أكبر من وسائل المواصلات العامة المزدحمة.
ومن المرجح ألا تصدق التوقعات بانخفاض الطلب بسبب سياسات المناخ. فالضائقة الاقتصادية التي تفرضها مخاطر الجائحة تتسبب في تقويض تطلعات السياسات المناخية، وكذلك يفعل التوجه الحالي نحو الانعزالية والابتعاد عن النوع من التعاون العالمي المطلوب لإيجاد سياسة مناخية فاعلة.
وفي المقابل، ستستغرق الإمدادات البترولية وقتا أطول كي تتعافى، نظرا لخسارة الإنتاج من الآبار المغلقة، وإلغاء الاستثمارات في مصادر الإمداد الجديدة، وتباطؤ ثورة البترول الصخري الأمريكي.
ومع تسبب التخمة البترولية في دفع عملية تخزين البترول العالمية إلى حدودها القصوى، حيث ستمتلئ الخزانات البرية عن آخرها خلال هذا الشهر، سيكون من الضروري إغلاق عدد غير مسبوق من آبار البترول المنتجة. ومثل هذا الإجراء ينذر بخطر إلحاق الضرر بالمكامن.
ولذلك، فإن بعض هذه المكامن لن يعود إلى العمل مجددا أبدا، بينما سيستغرق البعض الآخر فترة طويلة، وسيتطلب استثمارات كبيرة لكي يعود إلى الإنتاج مرة أخرى. وتشير توقعات شركة إنرجي أسبكتس، وهي شركة للاستشارات البترولية، إلى احتمال تعرض أربعة ملايين برميل، من إمدادات البترول اليومية، لمخاطر الضرر شبه الدائم.
كذلك، قامت شركات البترول الكبرى، مثل شركتي شيفرون وإكسون موبيل، بخفض مصروفاتها الرأسمالية كرد فعل على انهيار الأسعار. حتى مع احتمال عدم تحقق أي نمو في الطلب على البترول، فإن من الضروري إضافة ستة ملايين برميل بترول يوميا، من مصادر إمداد جديدة في كل عام، من أجل تعويض انخفاض الإنتاج العائد لأسباب طبيعية فحسب. وفضلا عن هذا، فقد البترول حظوته لدى المستثمرين، الذين باتوا قلقين بشأن العائدات الضعيفة لصناعة البترول، والضغوط السياسية والاجتماعية المتزايدة عليها.
أما صناعة البترول الصخري الأمريكي، بصفة خاصة، فستستغرق أعواما طويلة كي تعود إلى مستوياتها، التي كانت عليها قبل تفشي فيروس كورونا. واستنادا إلى المدة التي سيبقى فيها الطلب على البترول ضعيفا، فإن من المتوقع للإنتاج الأمريكي أن ينخفض 30 في المائة عن ذروته، التي بلغها قبل أزمة فيروس كورونا، والبالغة 13 مليون برميل يوميا. والأمر المؤكد هو أن تعافي أسعار البترول سيقود إلى رفع الإنتاج الأمريكي مجددا. ويبقى إنتاج الزيت الصخري ذا جدوى اقتصادية، خصوصا بالنسبة إلى الشركات التي تتمتع برؤوس الأموال الأكبر، التي ستبرز بمجرد انتقال ملكية أصول الشركات التي أعلنت إفلاسها، واندماج القوى في الصناعة.
وعلى الرغم من هذا، فإن النمو القوي الذي شهده البترول الصخري خلال الأعوام الأخيرة "بنمو إنتاج يراوح بين مليون ومليون ونصف المليون برميل يوميا في كل عام" قد انعكس، أيضا، على الوفرة غير المنطقية في الأسواق المالية؛ فعديد من الشركات الأمريكية، التي كافحت من أجل البقاء، في ظل إنتاج غير مجدٍ اقتصاديا، تمكنت من الإفلات من شبح الإفلاس بسبب دفعات الديون ذات الفائدة المنخفضة التي جرى ضخها لها، فقط.
وربما كان ربع إنتاج البترول الصخري الأمريكي غير مجدٍ، من الناحية الاقتصادية، حتى قبل انهيار الأسعار، حسب قول إد مورس، "الرئيس العالمي لقسم بحوث السلع الأساس في مجموعة "سيتي جروب" المصرفية". ودون هذه الزيادة غير المجدية، كان البترول الصخري سينمو بمعدل أبطأ بكثير، هذا إن حقق أي نمو أصلا. ويقدر أرجون مورتي؛ المحلل السابق في مؤسسة جولدمان ساكس، أنه حتى مع تعافي أسعار الخام الأمريكي إلى نحو 50 دولارا للبرميل، فسيراوح نمو الإنتاج الأمريكي السنوي بين صفر و500 ألف برميل يوميا، وهو ما لا يقارن بوضعه السابق.
وفي واقع الأمر، بينما تعمل أزمة فيروس "كوفيد – 19" على تهيئة الأجواء، في نهاية المطاف، لأسواق بترولية أكثر صرامة، وبالتالي أعلى أسعارا؛ فإن السعودية، إلى جانب عدد قليل من الدول الخليجية الأخرى وروسيا، لن تستفيد من ارتفاع الأسعار فحسب، بل إنها، فعليا، ستجد الفرصة متاحة أمامها لرفع حصتها السوقية، وبيع كميات أكبر من البترول، بل إنه حتى في الوقت الراهن، ومع التراجع الحاد الذي تشهده الأسعار، تجري كل من السعودية والكويت مناقشات حول إضافة مزيد من البترول إلى الأسواق، من حقل مشترك يمتد على الحدود بين البلدين.
أما الدول الأعضاء في "أوبك"، الأكثر هشاشة من الناحية الاقتصادية، فربما تجد صعوبة أكبر في الاستثمار في إعادة تفعيل عمليات الإمداد الخاصة بها وصيانتها (فضلا عن زيادتها)، وبالتالي فإن تلك الدول ستشهد تباطؤا في نمو الإنتاج. وهذا هو بالضبط ما حدث في كل من إيران والعراق ونيجيريا وفنزويلا في أعقاب الأزمة البترولية التي وقعت في عامي 1998و1999.
وأخيرا، عن طريق تعزيز تحالفها مع الولايات المتحدة، الذي بدا كأنه تأثر بهذه الأزمة، وإعادة ترسيخ مكانتها باعتبارها المنتج المرجح للبترول، تمكنت السعودية من تقوية مركزها الجيوسياسي. فبعدما تدافع كبار المنتجين والمستهلكين ساعين إلى الحيلولة دون أن يلقي العرض البترولي الفائض بتأثيره على مرافق التخزين في العالم، اتجهت أنظارهم، أخيرا، إلى السعودية كي تقود "أوبك"، وكبار المنتجين الآخرين، للتوصل إلى تخفيضات تاريخية في الإنتاج.
وعلى الرغم من كل الحديث الذي دار حول تحديد حصص إنتاج البترول في تكساس، أو حول إنشاء تكتل بترولي عالمي جديد، من خلال مجموعة العشرين (G-20)، كان اللجوء إلى الرياض هو الخيار الوحيد الحقيقي المتاح أمام صناع السياسات في نهاية المطاف، كما كان الأمر عليه منذ أمد طويل.
والسبب في هذا هو أن السعودية، ظلت منذ أمد بعيد، الدولة الوحيدة التي كانت على استعداد لأن تحتفظ بقدر معقول من القدرة الإنتاجية الاحتياطية، رغم التكلفة الكبيرة لهذا، وهو الأمر الذي مكنها من تعزيز أو تقليص الإمدادات إلى الأسواق بسرعة كبيرة. هذه الميزة التي تنفرد بها السعودية، التي أوضحتها مجددا للعالم، لا تعطي السعودية نفوذا على أسواق البترول العالمية فحسب، بل تمنحها تأثيرا جيوسياسيا كبيرا أيضا.
وفي الأسواق العالمية، سيظل هذا الوضع قائما إلى أن يقل اعتماد الدول على استخدام البترول، وهو هدف مهم تواصل سياسات المناخ السعي لتحقيقه.
وعن طريق قيادة الجهود الرامية لإنشاء اتفاق لخفض الإنتاج بين الدول المشاركة في تجمع "أوبك بلس"، قامت السعودية، أيضا، بتذكير موسكو بأن روسيا لا يمكنها أن تضطلع بالأمر بمفردها، كما كانت عليه الحال عندما حاولت أن تفعل ذلك، عندما انسحبت من مفاوضات "أوبك بلس" في آذار (مارس) الماضي، وأشعلت حرب الأسعار.
فموسكو تعتمد على الرياض في إدارة أسواق البترول بدرجة أكبر من اعتماد الرياض عليها في هذا الأمر؛ وهو ما يقوي موقف السعودية في علاقتها مع روسيا مع التداعيات المحتملة لذلك في الشرق الأوسط، حيث تتمتع موسكو بوجود عسكري متزايد، وتسعى إلى اتخاذ حلفاء لها بمن في ذلك سورية، وإيران؛ العدو اللدود للسعوديين.
وإضافة إلى هذا، قامت السعودية بتحسين موقفها في واشنطن. فبعد ضغوط شديدة من البيت الأبيض، ومن أعضاء نافذين في مجلس الشيوخ الأمريكي، أدى استعداد المملكة للالتزام بتخفيض الإنتاج إلى إصلاح بعض الضرر الذي وقع عندما جرى توجيه اللوم إلى المملكة بسبب انهيار أسعار البترول، بعد قيامها برفع الإنتاج في آذار (مارس) الماضي. وربما تكون السعودية قد قوضت، كذلك، خطط المشرعين الأمريكيين لسن تشريع مضاد لمنظمة أوبك.
من الصعب القول بأن منظمة أوبك تعد تكتلا إنتاجيا ضارا، في الوقت نفسه الذي توسل فيه طرفا شارع بنسلفانيا "البيت الأبيض والمجلس التشريعي الأمريكي" إلى المنظمة لكي تتصرف على أنها كذلك. وسيتأجج النقد اللاذع الأمريكي، مجددا، خلال الأسابيع المقبلة، عندما يصل أسطول من ناقلات البترول السعودية، بدأ رحلته في أثناء احتدام حرب الأسعار منذ شهرين، كي يقوم بتفريغ شحنته من البترول، التي تزيد بثلاثة أضعاف عما يتم تسليمه عادة، في الأسواق الأمريكية المتشبعة سلفا. لكن هذا يعني فقط أن السياسيين الأمريكيين سيضطرون، مرة أخرى، للتوسل إلى الرياض لتمدد تخفيضات الإنتاج، أو تزيدها، خلال الاجتماع المقبل لـ"أوبك بلس" في حزيران (يونيو).
منذ بضعة أسابيع مضت فحسب، كانت التوقعات الخاصة بالسعودية تبدو قاتمة. لكن إذا نظرنا إلى الأوضاع خلال بضعة أعوام مقبلة، فمن الصعب أن نرى السعودية إلا في وضع أقوى. وربما ينتهي الأمر بفيروس "كوفيد – 19" إلى تحقيق ما لم يتمكن القادة السعوديون من تحقيقه من قبل، عندما تركوا أسعار البترول تنهار، في أواخر عام 2014، في محاولة لم توفق لإضعاف صناعة البترول الصخري الأمريكي. وفي نظرة إلى ما بعد الأزمة الراهنة، سينتهي الأمر بجائحة كورونا معززة المركز الجيوسياسي للسعودية، ومعززة دورها المحوري في أسواق البترول، ومرسية القواعد أمام ارتفاع حصتها السوقية وعائداتها البترولية خلال الأعوام المقبلة.في مقال نشرته مجلة «فورين بوليسي»* مدير أعلى سابق في فريق عمل مجلس الأمن القومي الأمريكي، ومساعد خاص للرئيس باراك أوباما، وأستاذ للممارسة المهنية في الشؤون الدولية والعامة، والمدير المؤسس لمركز سياسات الطاقة العالمية في كلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا.
النص 1976 كلمة 21465 الاحرف
مع بقاء أربعة مليارات شخص في أنحاء العالم، تحت ظروف منع التجول، في الوقت الذي يتزايد انتشار جائحة فيروس كورونا، يشهد الطلب على كل من البنزين ووقود الطائرات والمنتجات البترولية الأخرى انخفاضا شديدا، كما هي الحال مع أسعار البترول تماما. حيث انخفض سعر برميل الزيت الخام في الولايات المتحدة، إلى مستوى متدنٍ للغاية، اضطر معه البائعون، أخيرا، إلى دفع الأموال لمن يخلصهم من الكميات الموجودة لديهم.
ونتيجة لهذا، باتت الاقتصادات التي تعتمد على البترول غير مستقرة. ففي الولايات المتحدة، أكبر منتج للبترول في العالم؛ هبط عدد حفارات البترول 50 في المائة خلال شهرين فقط، ومن الممكن أن يواجه 40 في المائة من منتجي الزيت والغاز الإعسار المالي خلال هذا العام، ومن المتوقع أن يفقد نحو 220 ألفا من العاملين في قطاع البترول وظائفهم.
وفي بقية أنحاء العالم، تعاني الدول البترولية معاناة كبيرة، من نيجيريا إلى العراق وكازاخستان، مع الهبوط الحاد الذي تشهده عملاتها، فيما تقف بعض الدول، مثل فنزويلا، على حافة هاوية اقتصادية واجتماعية سحيقة.
وعلى الرغم من أن عام 2020 سيذكر باعتباره عام الأزمة الحقيقية بالنسبة إلى الدول البترولية؛ فإن دولة واحدة، على الأقل، من المرجح أن تخرج من أزمة وباء كورونا وهي تتمتع بقدر أكبر من القوة على الجانبين الاقتصادي والجيوسياسي؛ وهي: المملكة العربية السعودية.
أولا، برهنت السعودية على أن إمكاناتها المالية قادرة على مواجهة عاصفة مثل هذه. فأسعار البترول المتدنية تعد مؤلمة، بطبيعة الحال، لدولة تحتاج إلى نحو 80 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في موازنتها العامة، الأمر الذي دفع وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى خفض توقعاتها المالية لها يوم الجمعة الماضي. فقد شهدت السعودية عجزا في الموازنة بلغ تسعة مليارات دولار خلال الربع الأول من عام 2020. وككل الدول الأخرى، شهدت أيضا تراجعا في العائدات الضريبية، في ظل قيامها بفرض قيود اقتصادية لوقف انتشار الجائحة.
وفي الأسبوع الماضي، صرح وزير المالية السعودي بأن الإنفاق الحكومي يجب "تخفيضه بشدة"، وأن بعض أجزاء خطة تنويع الاقتصاد، في رؤية المملكة 2030، سيتم تأجيل تنفيذها.
ومع ذلك، فعلى النقيض من أغلبية منتجي البترول الآخرين، لا تمتلك السعودية احتياطات مالية ضخمة فحسب، بل تمتلك أيضا قدرة واضحة على الاقتراض. فقد أعلن وزير المالية، في يوم 22 نيسان (أبريل)، أنه يمكن للمملكة أن تقترض مبلغا يصل إلى 58 مليار دولار في العام الجاري 2020.
ومقارنة بأغلبية الاقتصادات الأخرى، فإن معدل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، متدنية نسبيا، حيث بلغ 24 في المائة في نهاية عام 2019، على الرغم من أن هذا الرقم شهد تزايدا في الآونة الأخيرة.
كما قال وزير المالية، أيضا، إن المملكة قد تسحب مبلغا يصل إلى 32 مليار دولار من احتياطاتها المالية. ومع وجود مبلغ 474 مليار دولار، لدى البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي السعودي)، كاحتياطي من النقد الأجنبي، تقف المملكة بارتياح فوق مستوى الاحتياطي، البالغ 300 مليار دولار، الذي يعده الكثيرون الحد الأدنى، من احتياطي النقد الأجنبي، المطلوب لحماية العملة الوطنية للدولة، ألا وهي الريال، المرتبطة بالدولار.
ثانيا، بمجرد أن تستقر الأسواق، سينتهي المطاف بأن يكون لدى المملكة عائدات بترولية أعلى، ونصيب أكبر من سوق البترول، وذلك بفضل تخفيضات الإنتاج وعمليات الإغلاق التي تسبب فيها الهبوط الاقتصادي العالمي.
وتضع الحال الراهنة من الكساد في سوق البترول القواعد اللازمة لانتعاش الأسعار لاحقا خلال الأعوام المقبلة، ولتزايد عائدات المملكة تبعا لذلك. وعلى الرغم من أن توقعات الطلب المستقبلي على البترول غير مؤكدة إلى حد كبير، إلا أننا، بمجرد أن ننظر إلى ما بعد الأزمة الراهنة، سنرى أن من المرجح أن ينمو الطلب بمعدل أسرع من معدل نمو العرض.
وتشير توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن الطلب العالمي على البترول سيعود إلى مستوياته، التي كان عليها قبل الجائحة، مع نهاية عام 2020. كما أن لدى وكالة الطاقة الدولية القدر نفسه من التفاؤل، حيث تتوقع بأن يكون الطلب، مع نهاية العام، منخفضا يراوح بين 2 و3 في المائة فقط، عن متوسط الطلب في عام 2019، الذي كان قد بلغ 100 مليون برميل يوميا.
وإذا استمرت الإجراءات المتخذة لاحتواء الفيروس لوقت أطول من المتوقع، أو في حال ظهور موجة ثانية من الفيروس، فسيستغرق تعافي الأسواق وقتا أطول، لكن معظم السيناريوهات لا تزال تتوقع تعافي الطلب في نهاية المطاف.
ومع أنه بإمكان التغيرات التي طرأت على نمط الحياة أن تؤدي إلى انخفاض الطلب المستقبلي على البترول، إلا أن البيانات تشير إلى أن المرء ينبغي أن يشك في التنبؤات التي تتوقع حدوث تحولات دائمة.
ففي الصين، على سبيل المثال، استعاد كل من السفر بالسيارات وشحن البضائع بالشاحنات معدلاتها التي كانت عليها خلال العام الماضي، تقريبا، على الرغم من أن السفر بالطائرات، الذي يمثل مع الشحن الجوي 8 في المائة من الطلب العالمي على البترول بقي منخفضا بشدة.
ويمكن للطلب على البترول أن يشهد انتعاشا فعليا إذا قرر عدد أكبر من الناس أن السيارات الخاصة تجعلهم يشعرون بالأمان بدرجة أكبر من وسائل المواصلات العامة المزدحمة.
ومن المرجح ألا تصدق التوقعات بانخفاض الطلب بسبب سياسات المناخ. فالضائقة الاقتصادية التي تفرضها مخاطر الجائحة تتسبب في تقويض تطلعات السياسات المناخية، وكذلك يفعل التوجه الحالي نحو الانعزالية والابتعاد عن النوع من التعاون العالمي المطلوب لإيجاد سياسة مناخية فاعلة.
وفي المقابل، ستستغرق الإمدادات البترولية وقتا أطول كي تتعافى، نظرا لخسارة الإنتاج من الآبار المغلقة، وإلغاء الاستثمارات في مصادر الإمداد الجديدة، وتباطؤ ثورة البترول الصخري الأمريكي.
ومع تسبب التخمة البترولية في دفع عملية تخزين البترول العالمية إلى حدودها القصوى، حيث ستمتلئ الخزانات البرية عن آخرها خلال هذا الشهر، سيكون من الضروري إغلاق عدد غير مسبوق من آبار البترول المنتجة. ومثل هذا الإجراء ينذر بخطر إلحاق الضرر بالمكامن.
ولذلك، فإن بعض هذه المكامن لن يعود إلى العمل مجددا أبدا، بينما سيستغرق البعض الآخر فترة طويلة، وسيتطلب استثمارات كبيرة لكي يعود إلى الإنتاج مرة أخرى. وتشير توقعات شركة إنرجي أسبكتس، وهي شركة للاستشارات البترولية، إلى احتمال تعرض أربعة ملايين برميل، من إمدادات البترول اليومية، لمخاطر الضرر شبه الدائم.
كذلك، قامت شركات البترول الكبرى، مثل شركتي شيفرون وإكسون موبيل، بخفض مصروفاتها الرأسمالية كرد فعل على انهيار الأسعار. حتى مع احتمال عدم تحقق أي نمو في الطلب على البترول، فإن من الضروري إضافة ستة ملايين برميل بترول يوميا، من مصادر إمداد جديدة في كل عام، من أجل تعويض انخفاض الإنتاج العائد لأسباب طبيعية فحسب. وفضلا عن هذا، فقد البترول حظوته لدى المستثمرين، الذين باتوا قلقين بشأن العائدات الضعيفة لصناعة البترول، والضغوط السياسية والاجتماعية المتزايدة عليها.
أما صناعة البترول الصخري الأمريكي، بصفة خاصة، فستستغرق أعواما طويلة كي تعود إلى مستوياتها، التي كانت عليها قبل تفشي فيروس كورونا. واستنادا إلى المدة التي سيبقى فيها الطلب على البترول ضعيفا، فإن من المتوقع للإنتاج الأمريكي أن ينخفض 30 في المائة عن ذروته، التي بلغها قبل أزمة فيروس كورونا، والبالغة 13 مليون برميل يوميا. والأمر المؤكد هو أن تعافي أسعار البترول سيقود إلى رفع الإنتاج الأمريكي مجددا. ويبقى إنتاج الزيت الصخري ذا جدوى اقتصادية، خصوصا بالنسبة إلى الشركات التي تتمتع برؤوس الأموال الأكبر، التي ستبرز بمجرد انتقال ملكية أصول الشركات التي أعلنت إفلاسها، واندماج القوى في الصناعة.
وعلى الرغم من هذا، فإن النمو القوي الذي شهده البترول الصخري خلال الأعوام الأخيرة (بنمو إنتاج يراوح بين مليون ومليون ونصف المليون برميل يوميا في كل عام) قد انعكس، أيضا، على الوفرة غير المنطقية في الأسواق المالية؛ فعديد من الشركات الأمريكية، التي كافحت من أجل البقاء، في ظل إنتاج غير مجدٍ اقتصاديا، تمكنت من الإفلات من شبح الإفلاس بسبب دفعات الديون ذات الفائدة المنخفضة التي جرى ضخها لها، فقط.
وربما كان ربع إنتاج البترول الصخري الأمريكي غير مجدٍ، من الناحية الاقتصادية، حتى قبل انهيار الأسعار، حسب قول إد مورس، (الرئيس العالمي لقسم بحوث السلع الأساس في مجموعة "سيتي جروب" المصرفية). ودون هذه الزيادة غير المجدية، كان البترول الصخري سينمو بمعدل أبطأ بكثير، هذا إن حقق أي نمو أصلا. ويقدر أرجون مورتي؛ المحلل السابق في مؤسسة جولدمان ساكس، أنه حتى مع تعافي أسعار الخام الأمريكي إلى نحو 50 دولارا للبرميل، فسيراوح نمو الإنتاج الأمريكي السنوي بين صفر و500 ألف برميل يوميا، وهو ما لا يقارن بوضعه السابق.
وفي واقع الأمر، بينما تعمل أزمة فيروس "كوفيد – 19" على تهيئة الأجواء، في نهاية المطاف، لأسواق بترولية أكثر صرامة، وبالتالي أعلى أسعارا؛ فإن السعودية، إلى جانب عدد قليل من الدول الخليجية الأخرى وروسيا، لن تستفيد من ارتفاع الأسعار فحسب، بل إنها، فعليا، ستجد الفرصة متاحة أمامها لرفع حصتها السوقية، وبيع كميات أكبر من البترول، بل إنه حتى في الوقت الراهن، ومع التراجع الحاد الذي تشهده الأسعار، تجري كل من السعودية والكويت مناقشات حول إضافة مزيد من البترول إلى الأسواق، من حقل مشترك يمتد على الحدود بين البلدين.
أما الدول الأعضاء في "أوبك"، الأكثر هشاشة من الناحية الاقتصادية، فربما تجد صعوبة أكبر في الاستثمار في إعادة تفعيل عمليات الإمداد الخاصة بها وصيانتها (فضلا عن زيادتها)، وبالتالي فإن تلك الدول ستشهد تباطؤا في نمو الإنتاج. وهذا هو بالضبط ما حدث في كل من إيران والعراق ونيجيريا وفنزويلا في أعقاب الأزمة البترولية التي وقعت في عامي 1998و1999.
وأخيرا، عن طريق تعزيز تحالفها مع الولايات المتحدة، الذي بدا كأنه تأثر بهذه الأزمة، وإعادة ترسيخ مكانتها باعتبارها المنتج المرجح للبترول، تمكنت السعودية من تقوية مركزها الجيوسياسي. فبعدما تدافع كبار المنتجين والمستهلكين ساعين إلى الحيلولة دون أن يلقي العرض البترولي الفائض بتأثيره على مرافق التخزين في العالم، اتجهت أنظارهم، أخيرا، إلى السعودية كي تقود "أوبك"، وكبار المنتجين الآخرين، للتوصل إلى تخفيضات تاريخية في الإنتاج.
وعلى الرغم من كل الحديث الذي دار حول تحديد حصص إنتاج البترول في تكساس، أو حول إنشاء تكتل بترولي عالمي جديد، من خلال مجموعة العشرين
(G-20)، كان اللجوء إلى الرياض هو الخيار الوحيد الحقيقي المتاح أمام صناع السياسات في نهاية المطاف، كما كان الأمر عليه منذ أمد طويل.
والسبب في هذا هو أن السعودية، ظلت منذ أمد بعيد، الدولة الوحيدة التي كانت على استعداد لأن تحتفظ بقدر معقول من القدرة الإنتاجية الاحتياطية، رغم التكلفة الكبيرة لهذا، وهو الأمر الذي مكنها من تعزيز أو تقليص الإمدادات إلى الأسواق بسرعة كبيرة. هذه الميزة التي تنفرد بها السعودية، التي أوضحتها مجددا للعالم، لا تعطي السعودية نفوذا على أسواق البترول العالمية فحسب، بل تمنحها تأثيرا جيوسياسيا كبيرا أيضا.
وفي الأسواق العالمية، سيظل هذا الوضع قائما إلى أن يقل اعتماد الدول على استخدام البترول، وهو هدف مهم تواصل سياسات المناخ السعي لتحقيقه.
وعن طريق قيادة الجهود الرامية لإنشاء اتفاق لخفض الإنتاج بين الدول المشاركة في تجمع أوبك بلس، قامت السعودية، أيضا، بتذكير موسكو بأن روسيا لا يمكنها أن تضطلع بالأمر بمفردها، كما كانت عليه الحال عندما حاولت أن تفعل ذلك، عندما انسحبت من مفاوضات "أوبك بلس" في آذار (مارس) الماضي، وأشعلت حرب الأسعار.
فموسكو تعتمد على الرياض في إدارة أسواق البترول بدرجة أكبر من اعتماد الرياض عليها في هذا الأمر؛ وهو ما يقوي موقف السعودية في علاقتها مع روسيا.
(مع التداعيات المحتملة لذلك في الشرق الأوسط، حيث تتمتع موسكو بوجود عسكري متزايد، وتسعى إلى اتخاذ حلفاء لها بمن في ذلك سورية، وإيران؛ العدو اللدود للسعوديين).
وإضافة إلى هذا، قامت السعودية بتحسين موقفها في واشنطن. فبعد ضغوط شديدة من البيت الأبيض، ومن أعضاء نافذين في مجلس الشيوخ الأمريكي، أدى استعداد المملكة للالتزام بتخفيض الإنتاج إلى إصلاح بعض الضرر الذي وقع عندما جرى توجيه اللوم إلى المملكة بسبب انهيار أسعار البترول، بعد قيامها برفع الإنتاج في آذار (مارس) الماضي. وربما تكون السعودية قد قوضت، كذلك، خطط المشرعين الأمريكيين لسن تشريع مضاد لمنظمة أوبك.
من الصعب القول بأن منظمة أوبك تعد تكتلا إنتاجيا ضارا، في الوقت نفسه الذي توسل فيه طرفا شارع بنسلفانيا (البيت الأبيض والمجلس التشريعي الأمريكي) إلى المنظمة لكي تتصرف على أنها كذلك. وسيتأجج النقد اللاذع الأمريكي، مجددا، خلال الأسابيع المقبلة، عندما يصل أسطول من ناقلات البترول السعودية، بدأ رحلته في أثناء احتدام حرب الأسعار منذ شهرين، كي يقوم بتفريغ شحنته من البترول، التي تزيد بثلاثة أضعاف عما يتم تسليمه عادة، في الأسواق الأمريكية المتشبعة سلفا. لكن هذا يعني فقط أن السياسيين الأمريكيين سيضطرون، مرة أخرى، للتوسل إلى الرياض لتمدد تخفيضات الإنتاج، أو تزيدها، خلال الاجتماع المقبل لـ"أوبك بلس" في حزيران (يونيو).
منذ بضعة أسابيع مضت فحسب، كانت التوقعات الخاصة بالسعودية تبدو قاتمة. لكن إذا نظرنا إلى الأوضاع خلال بضعة أعوام قادمة، فمن الصعب أن نرى السعودية إلا في وضع أقوى. وربما ينتهي الأمر بفيروس "كوفيد – 19" إلى تحقيق ما لم يتمكن القادة السعوديون من تحقيقه من قبل، عندما تركوا أسعار البترول تنهار، في أواخر عام 2014، في محاولة لم توفق لإضعاف صناعة البترول الصخري الأمريكي. وفي نظرة إلى ما بعد الأزمة الراهنة، سينتهي الأمر بجائحة كورونا معززة المركز الجيوسياسي للسعودية، ومعززة دورها المحوري في أسواق البترول، ومرسية القواعد أمام ارتفاع حصتها السوقية وعائداتها البترولية خلال الأعوام المقبلة.
* مدير أعلى سابق في فريق عمل مجلس الأمن القومي الأمريكي، ومساعد خاص للرئيس باراك أوباما، وأستاذ للممارسة المهنية في الشؤون الدولية والعامة، والمدير المؤسس لمركز سياسات الطاقة العالمية في كلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا.