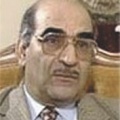العلاقة بين العقل والوجود في الرؤية البيانية
من المشكلات الكبرى في الفلسفة مشكلة العلاقة بين العقل والوجود. وقد انعكس هذا المشكل على التأليف الكلاسيكي في الفلسفة حيث نجد مبحث المعرفة ومبحث الوجود يقدَّمان كقارتين مستقلتين تشكلان مع مبحث القيم القارات الثلاث التي يتحرك فيها الدرس الفلسفي. وهذا التصنيف القاري لموضوعات الفلسفة لم تكن تمليه الاعتبارات البيداغوجية وحدها، بل كانت تفرضه فرضا طبيعة العلاقة بين تلك القارات بعضها مع بعض. ذلك أن محاولة إقامة جسر بيداغوجي بين مبحث المعرفة ومبحث الوجود، أو بين أحدهما وبين مبحث القيم، يتطلب ''التفلسف''، بمعنى أن هذا الجسر لا يمكن أن يكون إلا وجهة نظر فلسفية، وفي أكثر الموضوعات الفلسفية تعقيدا. ولذلك كانت بيداغوجيا التأليف الفلسفي الكلاسيكي تفضل استكشاف كل قارة على حدة، دون الانشغال بمسألة الجسر.
هذا في الفكر الفلسفي الكلاسيكي، أما في الحقل المعرفي البياني فالمسألة أيسر وأهون. بل يمكن القول إن الانتقال من ''العقل'' إلى ''الوجود'' لا يطرح أي مشكلة بيداغوجية من النوع الذي ذكرنا، ولكن شريطة أن نفهم العقل والوجود فهما بيانيا، أي كما يتحددان في الإطار المرجعي البياني. أما معنى ''العقل'' في هذا الإطار فقد عرفناه. إنه باختصار: العلم. وأما ''الوجود'' -بالمعنى البياني للكلمة- فهذا ما سنتعرف عليه في هذا المقال. ويكفي للانتقال إليه أن نضع، كجسر، السؤال التالي : إذا كان ''العقل'' هو ''العلم''، والعلم'' يقتضي معلوما ولا بد، فما ''المعلوم''؟ وما أصنافه ؟
يقدم البيانيون عن هذا السؤال جوابين : أحدهما للمعتزلة، والآخر للأشعرية. المعتزلة يقولون كل معلوم هو ''شيء''. وبما أن من المعلومات ما لم يعد موجودا، أو غير موجود أصلا، أو غير ممكن أن يوجد، أي ما هو ''معدوم'' فقد سموا هذا النوع من المعلومات أشياء معدومة فقلوا بـ ''شيئية المعدوم''. أما الأشعرية فقد ميزوا في ''المعلوم'' بين ما هو ''شيء'' أي موجود وما هو ليس بـ ''شيء'' أي معدوم. وبعبارة قصيرة المعتزلة يقولون عن المعدوم إنه شيء، والأشعرية يقولون عنه ليس بشيء، أي أنه مجرد نفي.
كان المعتزلة هم الذين أثاروا مسألة المعدوم ثم انقسموا حولها إلى رأيين:
الأول يقول : الموجود هو ''الكائن الثابت'' وبالتالي المعدوم هو ''المنتفي الذي ليس بكائن ولا ثابت''. وإذا قرأنا هذا التعريف داخل الحقل المعرفي البياني وجدناه مستقى مباشرة من اللغة. يقال : كان يكون كونا أي وجد واستقر، (كان: الفعل التام، لا الناقص باصطلاح النحاة) وإذن فالموجود بهذا المعنى هو الحادث، أو المخلوق، المستقر، الثابت. ومن هنا كان ''المعدوم'' هو ما انتفى عنه الحدوث والاستقرار، أي الفاني. فالجوهر الفرد –كما بينا قبل- لا يوجد إلا بأن يخلق الله فيه أعراضا، وإذا كف الله عن خلق الأعراض فيه فني وزال. فما دامت الأعراض تتوالى عليه فهو موجود مخلوق حادث مستقر ثابت. وإذا أمسك الله عن خلق الأعراض فيه فني وانتفى.
وأما الرأي الثاني فيقول إن تعريف الموجود يجب أن يكون بالإشارة إلى الموجودات، ومعنى ذلك أن التعريف الأوضح المبين هو التعريف بالمثال، كأن نقول : الموجود هو كهذه الشجرة أو مثل هذا الكرسي أو كهذا الرجل! وإذن فمفهوم ''الوجود'' في الحقل المعرفي البياني يختلف عن مفهومه عند الفلاسفة. ذلك لأنه إذا كان الوجود عند الفلاسفة être, to be هو ''لفظ مشترك يقال على جميع المقولات'' لكونه أكثر الأشياء كلها عمومية وكلية كما يقول أرسطو، أو أنه ''اسم لجنس من الأجناس العالية على أنه ليست له دلالة على ذاته، ثم يقال على كل ما تحت كل واحد منها على أنه اسم لجنسه العالي'' كما يقول الفارابي، فإنه عند المتكلمين يدخل تحت مقولة أعم هي ''المعلوم''. فالمعلوم عندهم : ''لفظ مشترك يقال على كل شيء''. وفي هذا المعنى يقول الجبائي. ''القول ''شيء'' : سمة لكل معلوم، ولكل ما أمكن ذكره والإخبار عنه''. ولذلك يرى ''أن القول في الباري إنه ''موجود'' قد يكون بمعنى : ''معلوم''، وأن الباري لم يزل واجدا للأشياء بمعنى أنه لم يزل عالما وأن المعلومات لم تزل موجودات لله، معلومات له بمعنى أنه لم يزل يعلمها. وقد يكون (الله) موجودا بمعنى لم يزل معلوما. وبمعنى لم يزل كائنا, وهكذا فالمعلوم، لا الموجود، هو أعم المقولات عند البيانيين.
والخلاف بين المعتزلة والأشعرية في هذه المسألة يدور حول تعريف ''الشيء''. هل ''الشيء'' هو الموجود فقط، مثل هذه الطاولة وهذا الكرسي وغيرهما من الأشياء الموجودة بالمعنى البياني للكلمة، أي الثابتة المتمكنة، وهذا رأي الأشعرية، أم أن لفظ ''الشيء'' يشمل كل ''معلوم''، موجودا كان أو معدوما كما يقول المعتزلة؟ وهم جميعا متفقون على أن ''المعلوم'' قسمان : الموجود وهو شيء عندهم جميعا، والمعدوم وهو شيء عند المعتزلة، وليس بشيء عند الأشعرية الذين يعتبرونه مجرد منتف. يقول الباقلاني شيخ الأشعرية في عصره : ''والمعدوم منتف ليس بشيء : فمنه معلوم معدوم ولم يوجد قط ولا يصح أن يوجد قط، وهو المحال الممتنع الذي ليس بشيء، وهو القول المتناقض نحو اجتماع الضدين وكون الجسم في مكانين … ومنه معدوم لم يوجد قط ولا يوجد أبدا وهو مما يصح ويمكن أن يوجد، نحو ما علم الله أنه لا يكون من مقدوراته وأخبر ألا يكون، من نحو رده أهل المعاد إلى الدنيا … ومنه معلوم معدوم في وقتنا هذا وسيوجد فيما بعد مثل الحشر والنشر… وقيام الساعة ... ومعلوم آخر هو معدوم في وقتنا هذا وقد كان موجودا قبل ذلك نحو ما كان وتقضى من أحوالنا وتصرفاتنا… ومعلوم آخر معدوم قبل ذلك يمكن عندنا أن يكون ويمكن أن لا يكون ولا يُدرَى أيكون أم لا يكون نحو ما يقدر الله تعالى عليه مما لا نعلم نحن أيفعله أم لا يفعله نحو تحريك الساكن من الأجسام وتسكين المتحرك وأمثال ذلك''
أما شيخ المعتزلة في عصره أبو هاشم الجبائي فقد حدد المسألة كما يلي: قال :
- ''وما سمي به الشيء لنفسه فواجب أن يسمى به قبل كونه، كالقول جوهر، وكذلك سواد وبياض وما أشبه ذلك'' ، فهذه كلها تدخل تحت مقولة ''المعدوم شيء''.
- ''وما سمي به لوجود علة ليست فيه، فقد يجوز أن يسمى به مع عدمه وقبل كونه إذا وجدت العلة التي كان لها مسمى بالاسم، كالقول مدعو ومخبر عنه إذا وجد ذكره والإخبار عنه'' وهذا معناه أن الموجود الغائب، بعد حضوره، أو الفاني، بعد وجوده، يدخل هو أيضا تحت مقولة : ''المعدوم شيء''.
- ''وما سمي به الشيء لوجود علة فيه فلا يجوز أن يسمى به، قبل كونه، مع عدمه، كالقول متحرك وأسود وما أشبه ذلك''.
معنى ذلك أن ما يسمى به ''الشيء''، صنفان : صنف يجب أو يجوز أن يطلق عليه اسم ''شيء'' وبالتالي فهو إما موجود وإما معدوم. وصنف لا يجوز أن يطلق عليه اسم ''شيء''، وبالتالي فهو ليس موجودا ولا معدوما. فالحجر شيء، وبالتالي فهو إما موجود وإما معدوم. ومثله السواد. أما قولنا ''عالم'' فهو ليس بشيء، بل هو وصف يطلق على من قام به العلم، وهو بهذه الصفة ليس بمعدوم؛ ولكنه أيضا ليس بموجود لأن كل موجود شيء، وهو ليس بشيء، وإذا كان ذلك كذلك، أي لا هو معدوم ولا هو موجود، فما عساه يكون إذن ؟ يجيب أبو هاشم الجبائي: إنه ''حال''… ومن هنا المسألة التي أزَّمت علم الكلام تأزيما لم تقم له بعدها قائمة، أقصد: مسألة ''الحال''. وفي المقال القادم شرح لهذه الأزمة.