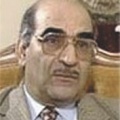الغلاة.. والموروث الهرمسي
تركزت ردود المعتزلة، التي أجملنا الكلام عنها في المقال السابق، على المانوية الذين هاجموا الإسلام من الخارج، مدافعين عن عقائدهم وكياناتهم، طارحين مذهبهم كبديل عن الإسلام ودولته... إلخ؛ وقد استطاع المعتزلة رد هذه الهجومات والطموحات. وعندما انشق عنهم أبو الحسن الأشعري، ملتمسا طريقا وسطا بين المعتزلة وبين أهل الحديث امتص هو وأتباعه من فكر المعتزلة كثيرا من قضاياه كما تبنوا منهجهم المفضل، منهج «الاستدلال بالشاهد على الغائب»، واستعملوه في الرد على «المخالفين» لمذهبهم بما فيهم المعتزلة. وعندما اشتد الجدل بين المتكلمين داخل نظرية «الجوهر الفرد» وقعت طريقتهم (التي يسميها ابن خلدون طريقة المتقدمين) في «أزمة الأحوال»، مما حدا بأحد أقطاب الأشعرية، «حجة الإسلام» أبي حامد الغزالي إلى الدعوة إلى تبني المنطق الصوري الأرسطي، وكان ذلك إيذانا بقيام «طريقة المتأخرين» التي اختلطت فيها مسائل الكلام بمسائل الفلسفة، خاصة مع فيلسوف الأشعرية الفخر الرازي.
وخلافا لما يعتقد – وهذا ما يجب التأكيد عليه بقوة - فإن المعتزلة ظلوا متمسكين بمفاهيمهم وبمنهجهم (قياس الغائب على الشاهد) رافضين التعامل مع الفكر اليوناني، سواء كمنهج أو كمفاهيم؛ لقد كتبوا مؤلفات في «الرد على أرسطوطاليس (النظام، أبو هاشم الجبائي... إلخ). وبصورة عامة كان «الخطر الأحمر» الذي فصل بينهم وبين الفكر اليوناني وغيره هو القول بـ «الطبع والطبيعة» الشيء الذي رفضه المعتزلة من أول أيامهم إلى آخرها، لأنه يؤدي في نظرهم إلى القول بقدم العالم واكتفائه بذاته، ولذلك نجدهم يؤكدون الأسباب والتولد. أما الأشعرية فقد تجاوزوا فكرة «الطبع والطبيعة» بالقول بـ «العادة»، (عادتنا نحن في الاعتقاد أن من طبع النار أن تحرق ولا بد، أما هي في ذاتها فهي تفعل أو لا تفعل حسب الإرادة الإلهية. وهذا يفسح مجالا لخرق العادة أي المعجزة). وقد كرس الغزالي هذا المفهوم تكريسا في رده على الفلاسفة، مقيما، دون أن يقصد، جسرا جديدا بين فكر الأشعرية وأرسطو.
على أن دعوة الغزالي إلى تبني المنطق الصوري الأرسطي لم يكن بسبب «أزمة الأحوال» وحدها، بل كان أيضا وبالأساس لأسباب سياسية. ذلك أن هجوم «أهل الملل والنحل» على الإسلام من قبل، وقد كان هجوما بالجملة ومن الخارج، قد تطور إلى نوع من التمطيط المدمر، بالتمييز بين «الظاهر والباطن» في كل شيء، وفي النصوص الدينية بكيفية خاصة. يتعلق الأمر إذن بالتيارات الباطنية التي تجند الغزالي لمهاجمتها و»فضحها» وإثبات مخالفتها مضمونا وشكلا لـ «مدارك العقول» (يعني «قواعد المنطق الصوري الأرسطي) التي هي عنده «القسطاس المستقيم» المستعمل في القرآن الكريم.
وقبل أن ندخل في تفاصيل هذه المرحلة، مرحلة بلوغ «الباطنية» مع الدولة الفاطمية (الإسماعيلية) أوج قوتها، زمن الغزالي بالذات، نرى من المفيد القيام بإطلالة سريعة على المرحلة التي سبقتها، مرحلة النشأة والتأسيس التي تمتد من أواخر العصر الأموي إلى انقسام الشيعة بعد وفاة جعفر الصادق إلى فريقين رئيسيين:
1) السبعية وهم الإسماعيلية، أتباع الإمام السابع: (= علي، الحسن، الحسين، علي زين العابدين، محمد بن علي الباقر، ثم ابنه جعفر الصادق، ثم إسماعيل ابن هذا الأخير). قيل إن أباه جعفر قد نص عليه كإمام من بعده، وعندما مات إسماعيل قبل أبيه ساق أتباعه الإمامة إلى ابنه محمد (؟).
2) الاثنا عشرية وهم الذين ساقوا الإمامة بعد جعفر إلى ابنه الثاني موسى الكاظم ومنه إلى أئمتهم من بعده.. إلى الإمام الثاني عشر «الغائب»: الحسن العسكري.
وما يهمنا هنا هم بعض الأشخاص الذين أطلق مؤرخو الفرق عليهم اسم «الغلاة» والذين تحلقوا حول أئمة الشيعة، يغالون في السمو بهم إلى مرتبة النبوة، وأحيانا مرتبة الألوهية، وقد كانوا بمثابة «العلماء الخبراء» في حاشيتهم، وكان مرجعهم الأساسي ذلك التيار (الغنوصي العرفاني) المعروف بـ «الهرمسية»، وهي فلسفة دينية خليط من الديانات المصرية القديمة ومن المذاهب الفلسفية المتأخرة المعروفة بالتوفيق والتلفيق (الأفلاطونية المحدثة بكل أشكالها خاصة الغنوصية منها). وكانت هذه الديانة الفلسفية «الخليط» قد ظهرت وانتشرت في الإسكندرية في القرن الثاني بعد الميلاد، ومنها انتقلت مع قيام الإسلام إلى أنطاكية وأفامية وحران شمال سورية، وإلى فارس والعراق (الكوفة خاصة).
ومن أهم العقائد التي تميز التيارات الهرمسية كافة:
1) «القول بإله واحد لا يعبر عنه بوصف ولا يدرك بالعقل وإنما يتوصل إليه بالزهد والتطهير ومواصلة الدعاء والتبتل».
2) القول بترابط واتصال العالم السفلي والعالم العلوي وتوظيف ذلك في علوم التنجيم والكيمياء والسحر والطلسمات... إلخ، أي «العلوم السرية».
على أن ما ركز عليه «الغلاة» الأوائل الذين التقطوا شظايا من الفلسفة الدينية الهرمسية هو توظيف فكرة الاتصال تلك لادعاء النبوة لمن كانوا يعملون في دائرتهم من أئمة الشيعة، أو ادعائها لأنفسهم. وتشير كل الدلائل إلى أن الكوفة كانت مركزا للهرمسية منذ العصر الأموي. يقول المستشرق المعروف لويس ماسينيون الذي اهتم بالموضوع: «إن الغلاة الأوائل من شيعة الكوفة قد اطلعوا على نصوص هرمسية»، ويؤكد ذلك تلميذه هنري كوربان الذي قال: «فليس من الغريب أن تكون الشيعة أول من تهرمس في الإسلام» وأن يكون الإسلام «قد عرف الهرمسية قبل أن يعرف قياس أرسطو وماورائياته».
بالفعل حفظت لنا كتب الفرق كثيرا من الأطروحات التي قال بها من تطلق عليهم اسم «الغلاة». وفيما يلي أمثلة:
- كان بيان بن سمعان (المقتول سنة 119 هـ، قتله خالد بن عبد الله القسري) من الغلاة القائلين بإلهية علي بن أبي طالب، قال : «حل في علي جزء إلهي واتحد بجسده: فمنه كان يعلم الغيب...، وبه كان يحارب الكفار...، وبه قلع باب خيبر»... إلخ. قال: «وربما يظهر عليٌ في بعض الأزمان! وقال في تفسير قوله تعالى: «»هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام » أراد به علياً فهو الذي يأتي في الظل، والرعد صوته والبرق تبسمه» (عن الشهرستاني، الملل والنحل)..
أما آراء المغيرة البجلي (أو العجلي؟) والمتوفى مقتولا هو الآخر سنة 119هـ فقد كان يقول إنه «نبي وإنه يعلم اسم الله الأكبر» وإن الله «رجل من نور على رأسه تاج... وأنه كان عند ابتداء الخلق وحده لا شيء معه، فلما أراد أن يخلق الأشياء تكلم باسمه الأعظم»، إلى آخر الأسطورة التي يحكيها عن عملية الخلق.
ومثل ذلك آراء الفرقة الخطابية (نسبة إلى أبي الخطاب) التي تزعم «أن كل ما يحدث في قلوبهم وحي، وأن كل مؤمن يوحى إليه»، وكان كثير منهم يشتغل بـ «الشعبذة والنرنجات والنجوم والكيمياء» مما لا يدع مجالا للشك في صلتهم الوثيقة بالأدبيات الهرمسية.
ولا بد من الإشارة هنا إلى إنكار الفرق الغالية من الشيعة، بل الشيعة كلها باستثناء الزيدية، لإمكانية التوصل إلى معرفة الله بطريقة النظر والقياس. ذلك أنهم «يزعمون أن المعارف كلها اضطرار.. وأن النظر والقياس لا يؤديان إلى علم، وما تعبد الله العباد بهما»، وبالتالي لا بد من «معلم» إمام، وهذا من مقتضيات «التوحيد» الهرمسي.
ويبدو من «المزاعم» السابقة، وغيرها كثير، أنه بمقدار ما كان الفكر العربي يتقدم في التدوين (= الترجمة والتأليف) بمقدار ما كان «العقل المستقيل» الذي تحمله الهرمسية والصيغة المشرقية من الأفلاطونية المحدثة، تحتل مواقع أساسية ومتجذرة في الثقافة العربية الإسلامية. وهذا ليس فقط في أوساط الشيعة والتيارات الباطنية والتصوف والفلسفة، بل نجد ذلك أيضا في حظيرة الفكر السني ذاته، وبالتخصيص فيما يدعى بـ «الإسرائيليات» التي تسربت بكثرة إلى الحديث، ومعظمها «هرمسيات» لا أصل لها في اليهودية، إلا ما كان قد «تهرمس» منها (التلمود خاصة). تلك هي الصورة «العالمة» للهرمسية التي احتلت مواقع في مختلف قطاعات الفكر العربي الإسلامي العقدية والعلمية، وذلك منذ منتصف القرن الثالث للهجرة، حينما انتقل «مجلس التعليم» (= أساتذة مدرسة الإسكندرية وكتبها) إلى حران، في عهد المتوكل، وانتقاله، كتبا وأساتذة، بعد ذلك بوقت قصير إلى بغداد. فابتداء من هذه المرحلة نجد أنفسنا ليس أمام «شظايا» هرمسية كما كان الحال من قبل، بل أمام نظريات متكاملة ومنظومات فكرية تعلن صراحة انتماءها الهرمسي، كما سنرى.