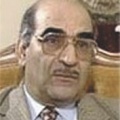من الفارابي «المعلم الثاني».. إلى «حجة الإسلام» الغزالي
قد يكون من المفيد، ونحن في صدد الانتقال إلى المرحلة الرابعة في هذه السلسلة من المقالات حول «دور العقل وأهله» في الدفاع عن الإسلام والرد على مهاجميه من «أهل الملل والنحل» ... أقول قد يكون من المفيد التذكير في عجالة بالمراحل السابقة حتى يتمكن من التحقوا بنا من القراء الأعزاء من تتبع خطواتنا في عرض فصول قصة «كفاح العقل في الإسلام» منذ أواخر العصر الأموي إلى عصر الجمود على التقليد أو «عصر الانحطاط».
كان أهل العلم في تاريخ الإسلام منشغلين في بداية الأمر (بداية العصر الأموي إلى أواخره) بعلوم اللغة والدين، فكان منهجهم في البحث يعتمد في الجملة إما على «الرواية» أو «الدراية»، دون أن تكون هناك بين المنهجين حدود نهائية. وإذا كانت الرواية تعني «السماع أو النقل» في الحديث كما في اللغة، فإن «الدراية» تعني «الاستحسان والقياس» في الدين (الفقه) كما في النحو واللغة، وفي كلتا الحالتين كان البحث يجري داخل دائرة النصوص، نصوص اللغة العربية المسموعة (في الغالب)، ونصوص الدين المكتوبة والمروية، والهدف تقعيد اللغة وتحصيل «العلم» (بمعنى العلم بأمور الدين: الحديث، والفقه... إلخ).
لكن عندما توغلت الفتوحات الإسلامية خارج الجزيرة العربية اتسعت دائرة دولة الإسلام بسرعة وباتت تعج بعرقيات وديانات وطوائف مختلفة، فصارت الرواية والدراية، بالمعنى الذي شرحناه، غير كافية في التعامل مع هذه الأقوام التي لا تعرف العربية، وبالتالي لم يعد ممكنا إفهام من يريد الفهم أو الرد على من ينتقد ويهاجم. فكان لا بد من «الكلام» مع هؤلاء بلغة العقل، وهي أعم من «اللسان» (لسان العرب وألسنة الأقوام غير العربية)، كان لا بد من استعمال حجج يركن إليها الناس مهما كانت لغاتهم: حجج العقل. ومنذ ذلك الوقت صار الدفاع عن الإسلام ضد هجمات «أهل الملل والنحل»، داخل المجتمع الإسلامي وخارجه، من مهمة فريق من علماء الإسلام عرفوا بـ «المتكلمين» (علماء الكلام، علماء الحجاج لنصرة عقائد الإسلام). وكان على هؤلاء أن يؤسسوا منهجا، ويبتكروا مفاهيم، ويشيدوا تصورات اتخذوها مرجعية يقارعون بها خصوم الإسلام، الذين لم يكن في إمكانهم التنكر لها لأنها مبنية على العقل والتجربة المباشرة، الطبيعية والاجتماعية، أعني ما أطلقوا عليه «الاستدلال بالشاهد على الغائب» الذي هو نوع من أنواع الاستدلال بالمعلوم على المجهول. وكان أصحاب هذه الطريقة الأوائل هم المعتزلة، وهم في الوقت نفسه أول من تجند لهذا النوع من الدفاع عن العقيدة الإسلامية. وعندما ظهرت في صفوف «أهل الملل والنحل» فرق جديدة توظف شذرات من الفلسفة الهرمسية ومن علوم الأوائل، متخذة «الغنوص» (أو العرفان) منهجا لها، مدعية الكشف عن «الباطن» في كل شيء، قادحة في العقل الذي يعتمده المتكلمون، زاعمة استمرار النبوة عبر هذا «الكشف» عن «الباطن»، وقد استفحل ذلك مع ظهور «رسائل إخوان الصفا» الإسماعيلية ... عندما حصل هذا لم يعد منهج المتكلمين (الاستدلال بالشاهد على الغائب) يكفي للتصدي لهؤلاء، - خصوصا بعد أن تعرض لأزمة داخلية - فأصبحت الحاجة ماسة إلى علوم الفلسفة العقلية، العلوم الطبيعة والمنطق... إلخ. وقد قام الكندي والفارابي، كل من جهته وحسب منظوره، بهذه المهمة، فتم بواسطتهما «تنصيب» العقل في الإسلام: «العقل الكوني» الذي هو القاسم المشترك بين جميع البشر، مهما كانت لغاتهم ودياناتهم.
كان علم الكلام والفلسفة - منذ واصل ابن عطاء (80-131هـ) الذي أسس فرقة المعتزلة والذي ألف عدة رسائل وكتب في الرد على المانوية، إلى الفارابي (260-339هـ) الذي قام بتقريب المنطق إلى أفهام الناطقين بالضاد وبتبيئته داخل الثقافة العربية (وكان ابن حزم قد فعل الشيء نفسه في الأندلس ولكن في حدود) .. الفارابي الذي وضع كذلك «الملة الفاضلة» (الإسلامية) كرد على «المدينة الإسماعيلية»، أقول كان علم الكلام والفلسفة هما الواجهتان اللتان واجه فيهما الإسلام محاولات «الفتح المضاد» الذي حاول القيام به «أهل الملل والنحل»: لقد توقف الفتح العربي، السياسي والديني، الموجه إلى «الخارج» ليحل محله «فتح مضاد» من طرف بعض أهل البلدان المفتوحة، موجهٌ إلى «الداخل»، إلى العقائد الإسلامية.. فكانت معركةً ثقافيةً ارتقت بالثقافة العربية الإسلامية إلى مستوى ثقافة العالم في عصرها: الثقافة التي أنتجت فلاسفة وعلماء في مختلف العلوم الطبيعية والاجتماعية، هم الذين نذكِّرُ بهم اليوم عند الرد على ما يتعرض له الإسلام في عصرنا من اتهامات من طرف كثيرين من الغربيين والصهاينة بكونه دين العقم والتزمت والانغلاق والعنف والجمود على التقليد. نحن نواجه اليوم هذه الاتهامات بالتذكير بعقلانية المعتزلة، وبإنجازات كثير من الفلاسفة العلماء أمثال الكندي، والفارابي، وابن سينا، وابن رشد، والخوارزمي، وابن الهيثم، وابن النفيس، والبتاني، وابن البنا، والبطروجي، وابن بصال، والقائمة طويلة.
ونحن إن نبرز هؤلاء المفكرين المبدعين في وجه خصومنا الخارجيين، لا ننسى أن المجتمع العربي الإسلامي قد مر بمحن قاسية جعلت كثيرين من رجاله يعادون كل شيء أجنبي منكفئين على «النفس»، مبعدين من قلب التجربة الحضارية العربية الإسلامية جل بُنَاتها فكان عصر «الجمود على التقليد»، العصر الذي كان فيه ذكر اسم «المعتزلة» مرفوقا بالدعاء: «قبحها الله»، وذكر اسم المنطق والفلسفة مرفوقا بالاتهام بـ «الزندقة» (من تمنطق تزندق)، وبـ «الكفر»، فكان الانسياق مع فهم مغلوط لكل من فتوى ابن الصلاح حول المنطق، وموقف الغزالي من «الفلاسفة»، من أكبر المظاهر التي لا يفسرها إلا القول: «الإنسان عدو ما يجهل»!
أنا شخصيا أرحب بكل نقد للمنطق والفلسفة، فمهمتهما تعليم الإنسان كيف ينتقد (كيف يفحص الدرهم، «درهم القول»)، وأكثر من ذلك أدافع عن «الحق في الخطأ» لكل من يستعمل عقله، أما هدفي فهو تقليص دائرة الجهل حتى لا يصبح الناس عندنا أعداء لبعضهم بعضا بسبب الجهل. إن الجهل يولد سوء الظن، وقرآننا الحكيم يخاطبنا: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ، إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ، وَلَا تَجَسَّسُوا (على الأحياء والأموات) وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا (أحياء وأمواتا): أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ» (الحجرات 12)
***
قلنا في مطلع هذا المقال إن هذا التذكير بمسار هذه المقالات هو من أجل قرائنا الأعزاء الذين لم يرافقونا منذ بداية هذه السلسلة (التي يجدون مقالاتها مرتبة حسب تاريخ نشرها في الموقع الإلكتروني لهذه الجريدة)، وهي تغطي عدة مراحل: مرحلة علم الكلام، مرحلة الكندي، مرحلة الفارابي. والآن نضيف: مرحلة حجة الإسلام أبي حامد الغزالي. والحق أن هذا التذكير قد انتهى به القول إلى ما يشبه مقدمة مناسبة للمرحلة الرابعة هذه.
يفصل بين الفارابي (260-339هـ) والغزالي (450-505هـ) نحو قرن ونصف. وإذا نحن استثنينا مجال الفقه والأصول الذي كان فيه للغزالي باعٌ طويل يجد تفسيره في المنافسة بين الأشعرية والمعتزلة وقتئذ، كما سنبين لاحقا، فإن باقي كتبه، لا يمكن أن تفهم مقاصدها والدوافع التي حركته لكتابتها بدون استحضار دوره في معركة الوزير نظام الملك السلجوقي مع الإسماعيلية، والمهام التي أوكلها له هذا الوزير، في هذا المجال بالذات. من أجل هذا كان من الضروري التعرف أولا على تطور الحركة الإسماعيلية منذ استنجاد دولة المأمون العباسي بمنطق أرسطو لمواجهة «التأويل» الباطني الذي اختارته طريقة لإنتاج إيديولوجيتها الدينية السياسية (راجع في هذا الموقع: مقالة « الغلاة والموروث الهرمسي»، والمقالات التالية لها).وفي نظرنا فإن هذا الدور الذي قام به أبو حامد الغزالي، والذي يمكن أن نختزله في عنوان كتابه «فضائح الباطنية» هو الذي أهله، في نظر من لقبوه بـ «حجة الإسلام» لحمل هذا اللقب. وفي المقالات التالية الشرح والبيان.