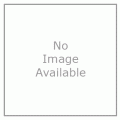ماذا حل بالنموذج السويدي؟
رغم صغر حجمها وقلة عدد سكانها - نحو 9 ملايين – فإن للسويد صيت. بيد أنني أرى أن صداه أخذ بالأفول وعدم الاكتراث بين كثير من الناس داخل السويد وخارجها.
وأنا أكتب هذا المقال أعلم علم اليقين أن القارئ اللبيب قد يثير بعض علامات الاستفهام وأهمها في نظري، تدور حول كيف ولماذا صارت السويد تخسر سمعتها كنموذج للحياد الإيجابي في عالم السياسة، وكنموذج يحتذى من حيث البعد الإنساني؟.
وفي حلي وترحالي حول العالم وأيضا أثناء تواجدي داخل السويد بالذات تُلقى على مسامعي أسئلة عديدة عن السويد، الدولة التي كانت وإلى وقت قصير الملاذ الآمن الذي يسعى الوصول إليه كل إنسان سُدت بوجهه طرق العيش الكريم، وكل إنسان هارب من الاضطهاد بأشكاله المختلفة.
الاقتصاد السويدي متين ولا أظن هناك خوف عليه في أقل تقدير ضمن المستقبل المنظور، بيد أن العيش في السويد من حيث المساواة والأمان وعدم التمييز ومتانة العرى الاجتماعية الاشتراكية، كل هذه ومع الأسف أخذت في الاضمحلال.
الناس خارج السويد تثير أسئلة عديدة مفادها ماذا حل بأسلوب الحياة في السويد من حيث الوجهة الاجتماعية والاشتراكية، وعلى الخصوص الاحترام الشديد الذي ربما لم يكن مثيلا له في العالم لحقوق الإنسان بغض الطرف عن اللون والميل والعرق وأي شيء آخر قد يُتخذ ذريعة للاعتداء والاضطهاد في أي مكان آخر.
النظرة السويدية الإنسانية للسياسة والتعامل مع الناس والعالم كان دائما منطلقها، أن الإنسان قيمة عليا من كان، ومن أي بقعة في العالم أتى، وإن حدث أن حطت أقدامه السويد طلبا للعدالة والمساوة والعيش الكريم، فله ما للمواطن السويدي من رعاية اجتماعية وحقوق إنسانية.
البعد الإنساني، هو الذي جعل السويد محط أنظار العالم، والباحة التي تستحق العناء وبذل الغالي والرخيص للهروب من واقع مرير للعيش في بحبوحتها.
حتى وإن كان الإنسان مضطهدا لحمله ميول قد لا تتلاقى مع ما هو سائد في المجتمع السويدي ذاته، فإن الدولة كانت ستمنحه حق العيش الكريم داخل حدودها. الاختلاف سياسيا كان أم ثقافيا، فإن السويد كانت تنظر إليه بمثابة قوة للمجتمع والعمود الذي يحمل سقوفه.
الوقوف في منتصف السياج وليس عن يمينه أو يساره كانت الميزة، التي تتباهى السويد بها ويتباهى العالم بالسويد بسببها.
انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي – أي انحدارها من الوقوف في منتصف السياج صوب يمينه –أخرج البلد من حياده الإيجابي الذي كانت الشعوب المضطهدة حول العالم تلوذ به لإسماع صوتها ورسالتها إلى العالم الغربي الرأسمالي الممسك بزمام المال وعجلة الاقتصاد والسلاح والعسكر.
لولا السويد لما كان هناك ناصر في الغرب لفيتنام وشعبها. السويد كانت الدولة الغربية الوحيدة، التي وقفت سياسيا وإنسانيا في وجه حرب فيتنام والولايات المتحدة والمعسكر الغربي وبوادر أول مظاهرات كبيرة ضد هذه الحرب المدمرة وقعت في عاصمتها، ستكهولم.
اليوم السويد جزء من حلف عسكري يحتم عليها التماهي مع سياساته وحروبه وصراعاته وحلفائه –من هنا يرى الكثيرون أن النموذج السويدي المناصر للشعوب التي تقع ضحية تحالفات عسكرية أو حروب تشن ضمن نطاق هذه التحالفات ربما صار أثرا بعد عين.
ومن هنا، حتى اللحظة لم تبد السويد موقفا إنسانيا واضحا على الساحة السياسية أو حتى الاجتماعية عن المأسي المهولة، التي ترافق الحرب في الشرق الأوسط وعلى الخصوص في غزة. السويد التي نعرفها لكان صوتها جهوريا واضحا مع الحق ومع المضطهدين الأبرياء، ولكن أظن أنها لم تعد التي نعرفها.
وهناك كثير من القصص، أن شقوقا بدأت تظهر في نموذج العدالة الاجتماعية السويدي، الذي كان حتى وقت قصير أفضل ما في الدنيا.
هناك عشرات أو ربما مئات من الروايات تدور على منصات وسائل التواصل الإجتماعية عن أحداث تشي بعدم المساواة ينقلها مواطنون من أصول أجنبية.
قد لا تكون كلها صحيحة، إلا أن مجرد التفكير بهكذا سيناريوهات أو قصص تشير إلى عدم المساواة في السويد كان محضا من الخيال في النموذج السويدي الذي كنا نعرفه ونجله ونتباهى به.
هل أصبح النموذج السويدي شيئا من الماضي؟