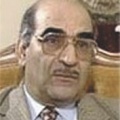العلم والظن...
يحرص البيانيون، متكلمون وفقهاء وغيرهم، على التمييز دائما بين "العلم" و"الظن". وإذا كانوا يضعون العلم والمعرفة والدراية على مستوى واحد فإنهم بالمقابل يضعون الظن ومجرد الاعتقاد على مستوى واحد أدنى من الأول. يقول القاضي عبد الجبار شيخ المعتزلة في عصره: "إن المعرفة والدراية والعلم نظائر، ومعناها ما يقتضي سكون النفس وثلج الصدر وطمأنينة القلب"، وهو يقصد بـ "سكون النفس" عدم اضطرابها في أمٍر اعتقدَه صاحبُها. أما إذا اضطربت إزاءه فإن ذلك لا يكون علما بل هو ظن ومجرد اعتقاد. فالاعتقاد والظن أقل درجة من العلم من حيث إن النفس لا تسكن فيهما : فالظن هو تردد وتأرجح بين هذا وذاك، والاعتقاد يدخل فيه اعتقاد التقليد والاعتقاد في الحظ إلخ مما لا تسكن النفس إليه سكونا تاما، وبعبارة أخرى : "المراد بسكون النفس… التفرقة التي يجدها الواحد منا من نفسه، إذا رجع إليها، بين أن يعتقد كون زيد في الدار مشاهدة، وبين أن يعتقد كونه فيها بخبر واحد من أفناء الناس، فإنه يجد في إحدى الحالتين مزية وحالا لا يجدها في الحالة الأخرى. تلك المزية هي التي عبرنا عنها بسكون النفس". وإذا اعترض معترض بأن نفس الجاهل تسكن هي الأخرى إلى ما يعتقده وتطمئن إليه كان الجواب أن الفرق بين سكون الجاهل وسكون العالم إلى ما يعتقده كل منهما أن العالم "يعلم من نفسه أنها ساكنة إلى ما علمه"، وليس كذلك الجاهل. ومعنى ذلك أن سكون نفس العالم لا يكون عن تقليد ولا عن غفلة، كما هو حال الجاهل، وإنما يكون مع تحقق وانتفاء الشك عنه. إن سكون نفس العالم "يقتضي كون الاعتقاد علما، وإنه لذلك لا يجوز أن يشك ويرتاب، ويفارق حاله حال الظان والشاك".
العلم هو "سكون نفس العالم إلى ما يعتقده"، ليكن ذلك. ولكن ما أنواع العلوم التي تسكن إليها النفس هذا السكون ؟
يجمع البيانيون على أن العلوم، أو المعارف، صنفان لا ثالث لهما : معارف ضرورية وبالأحرى "اضطرارية"، ومعارف نظرية، مكتسبة أو"كسبية"، فلنتعرف على ما يقصدونه بكل منهما.
لا بد من التنبيه هنا مرة أخرى إلى أن البيانيين ينطلقون دوما، في تحديد مفاهيمهم ومصطلحاتهم، من السلطة المرجعية الأولى في حقلهم المعرفي : اللغة. وهكذا فمعنى "الضرورة" يتحدد، أول ما يتحدد، بالمعنى اللغوي للكلمة. يقول الباقلاني منظر المذهب الأشعري : "فإن قال قائل: فما معنى وصفكم للضروري منها (=المعارف) بأنه ضروري، على مواضعة المتكلمين؟ قيل له: معنى ذلك أنه علم يلزم نفس المخلوق لزوما لا يمكنه الخروج عنه ولا الانفكاك منه، ولا يتهيأ له الشك في متعلقه ولا الارتياب فيه. وحقيقة وصفه بذلك في اللغة أنه مما أكره العالم به على وجوده، لأن الاضطرار في اللغة هو الحمل والإكراه والإلجاء". ويقول القاضي عبد الجبار : "الضرورة في أصل اللغة هي الإلجاء"، قال تعالى: "إلا ما اضطررتم إليه" أي ألجئتم إليه. وفي العرف إنما يستعمل فيما يحصل فينا لا من قبلنا، بشرط أن يكون جنسه داخلا تحت مقدورنا، ولذلك يقال: حركة ضرورية لما دخل جنسها تحت مقدورنا، ولم يُقَل : لون ضروري لمَّا لم يدخل جنسه تحت مقدورنا. هذا وإذا كان مطلقا، وإذا أضيف إلى العلم فقيل : علم ضروري، فالمراد… العلم الذي يحصل فينا لا من قبلنا ولا يمكن نفيه عن النفس بوجه من الوجوه.
عنصران أساسيان يتحدد بهما مفهوم "الضرورة" في هذا المجال عند المتكلمين: أولهما الإكراه والإلجاء أي انتفاء الحرية والاختيار، وثانيهما الدخول تحت مقدورات الإنسان، بمعنى أن يكون الضروري من جنس الأمور التي أقدر الله الإنسان عليها كالحركة والعلم إلخ. أما ما يدخل في الأمور التي لم يُقدِر الله الإنسان عليها فلا يوصف بالضروري. وهكذا فالحركة توصف بأنها ضرورية إذا نسبت للإنسان لأن الله منحنا القدرة على الحركة، ولكن اللون لا يوصف بأنه ضروري لأن الله لم يمنحنا القدرة على إعطاء الزهرة لونها...
على هذا الأساس وفي إطار هذا الفهم لـ "الضرورة" يصنف الباقلاني "العلوم الضرورية" إلى صنفين :
- صنف يحصل في النفس "عند إدراك حاسة من الحواس التي تختص، في وقتنا هذا على عادة جارية، بإدراك جنس أو أجناس : فحاسة الرؤية ندرك بها اليوم الألوان والأكوان والأجسام، وحاسة السمع تدرك الكلام والأصوات، وحاسة الشم ندرك بها الأرايح، وحاسة الذوق تدرك بها الطعوم، وحاسة اللمس وكل عضو فيه حياة تدرك بها الحرارة والبرودة واللين والخشونة والرخاوة والصلابة، على قول من زعم أن اللين والخشونة والرخاوة والصلابة معان زائدة توجد بالجواهر كالحرارة والبرودة". كل هذه "المعارف" -أي الإحساسات- ضرورية بمعنى أنها تحصل فينا اضطرارا، فنحن لسنا أحرارا في معرفة ما نراه أو نسمعه، بل نحن مضطرون إلى ذلك بفعل وظيفة العين والأذن، وإن كانت هذه الوظيفة غير دائمة ولا خاضعة لمبدأ السببية، بل هي "في وقتنا هذا على عادة جارية" أي أنها خاضعة لمبدأ التجويز (بمعنى أن الله قادر على أن يجعلها على غير ما هي عليه).
- أما الصنف الثاني فهو "ضرورة تخترع في النفس ابتداء من غير أن تكون موجودة ببعض هذه الحواس، كعلم الإنسان بوجود نفسه وما يجده فيها من الصحة والسقم واللذة والألم والغم والفرح والقدرة والعجز والإرادة والكراهية"، وكعلم المتكلم بما يقصد عندما يخاطب شخصا معينا، وكالعلم بأن الأشياء إما أن تكون مجتمعة متماسة أو مفترقة متباينة، وأن الخبر إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا "وما جرى مجرى ذلك من الأمور المنقسمة في العقل إلى أمرين لا واسطة بينهما"، وكالعلم بالخجل والشجاعة والبِرِّ والاستهزاء "الواقع عند مشاهدة الأمارات" الدالة على ذلك، وكالعلم "المخترع في النفس بما تواتر الخبر عن كونه واستفاض عن وجوده. وقد يصح أن يخترع الله العلم بوجود المخبر عنه من غير سماع خبر عنه في الزمن الذي يصح فيه خرق العادة وإظهار المعجزات وخروج الأمور عما هي عليه في العادة"...
ولا يختلف موقف المعتزلة في هذه المسألة عن موقف الأشاعرة كبير اختلاف، بل إن مفهوم الضرورة بهذا المعنى يعود إليهم. وإذا كان بعضهم، كالجاحظ، قد ذهب "إلى التسوية بين النظر والمعرفة وبين إدراك المدركات في أن جميع ذلك يقع بالطبع". فإن أقطابهم قد رفضوا فكرة الطبع كما بينا ذلك قبل، كما أنهم ميزوا في المعارف بين ما يحصل في الإنسان "ضرورة" وبين ما يحصل فيه اكتسابا، ولكل أقسام...