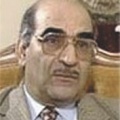انقلاب : من مسألة «الحال».. إلى مسألة «الكلي والجزئي»!
من الدواعي التي جعلت المتكلمين يقولون بـ''الحال'' كونُهم جعلوا ''المعلوم'' صنفين: ''الموجود'' و''المعدوم''، وبما أن الأحوال ''لا موجودة ولا معدومة''، فيلزم عن ذلك أنها أيضا ''لا معلومة''! ولكن كيف يمكن قبول هذه النتيجة ونحن نثبتها (=الأحوال) صفات للأشياء بها تتماثل وبها تختلف؟ إنها من هذه الناحية ''لا مجهولة''، كيف؟ وقد قلنا إنه يلزم أن تكون ''لا معلومة''! وإنما اضطر أبو هاشم إلى القول هو ومن تبعه من المعتزلة، إن الأحوال ''لا معلومة'' بسبب تمسكهم بأصلهم القائل : ''المعدوم شيء''. فلو قالوا إنها معلومة، والمعلوم عندهم قسمان موجود ومعدوم، والمعدوم عندهم شيء، فإنهم سيضطرون إلى القول، في كلتا الحالتين، إنها، أعني ''الأحوال''، ''شيء''! وبما أن ''الشيء'' عندهم إما موجود وإما معدوم فإن ''الحال'' ستكون بالضرورة إما موجودة وإما معدومة، بينما اضطروا إلى القول إنها لا موجودة ولا معدومة كما رأينا ذلك قبل، وإذن فلم يبق لهم إلا أن يقولوا إنها ''لا معلومة'' أي لا تدخل تحت مقولة ''المعلوم''، وهذا غير ممكن لأنهم يثبتونها للأشياء، فالرجل عالم أو جاهل، واللوح أسود أو أبيض .. إلخ، وإذن فهي ''لا مجهولة''.. لا تدخل تحت مقولة ''المجهول''...
وعندما اعترضوا على أبي هاشم بأنه إذا كانت الحال لا معلومة ولا مجهولة فكيف يجوز إثباتها وكيف يمكن فهمها؟ أجاب : أنا وإن لم أقل إن الحال معلومة فأقول إن الذات معلومة على الحال، بمعنى أننا نعلم أن هذا الشخص على حال من العلم، هي كونه عالما مثلا، يتميز بها عن شخص آخر هو على حال من الجهل، أي جاهل.
ذلك هو موقف أبي هاشم ومن تبعه من المعتزلة. أما مثبتو الأحوال من الأشاعرة فإنهم وإن قبلوا أن توصف بأنها ''موجودة ولا معدومة'' فإنهم قالوا إنها معلومة، وسوغوا ذلك بإدخال تعديل على قسمة المعلوم. فبدلا من قسمته إلى قسمين فقط، موجود ومعدوم، جعلوه ثلاثة أقسام. موجود ومعدوم وحال. يقول الجويني في هذا الصدد : ''المعلومات تنقسم إلى ثلاثة أقسام : أحدها وجود، والثاني عدم وانتفاء، والثالث وصف وجود وحال تتبعه، لا يوصف بالوجود على انفراد''. وإذا قال قائل: ''لست أفهم رتبة بين الوجود والعدم'' أجاب الجويني : بما أنك تفهم الوجود وتفهم العدم ''فنحن نثبت وصفا للوجود وننفي عن ذلك الوصف صفة الوجود والعدم''. ثم يضيف الجويني قائلا. ''والدليل على كون الحال معلومة أن تقول : من علم الذات ولم يحط بحالها علما (=كأن نعلم وجود زيد ولا نعلم هل هو عالم أم جاهل)، ثم علم بعد ذلك كون الذات على تلك الحال (أي علم أن زيدا عالم)، فنحن نعلم قطعا أنه عَلِم (= في المرة الثانية) ما لم يعلمه في المرة الأولى واستفاد ما لم يحط به علما أولا''.
ومن جملة ما وظفه مثبتو الأحوال للدفاع عن وجهة نظرهم تقسيم المتكلمين المعارف إلى صنفين، كما رأينا: معارف ضرورية ومعارف مكتسبة، فبناء على هذا التقسيم قالوا : إننا قد نعلم الذات ضرورة، كأن نرى زيدا من الناس بأعيننا واقفا أمامنا، وقد نعلم حالا لهذه الذات بالاستدلال، كأن نستدل من الأمارات التي تبدو على زيد أنه رجل عالم. وإذن، فهاهنا معلومان حصلنا عليهما على مرحلتين : المعلوم الأول هو ذات زيد، والمعلوم الثاني هو كونه عالما. فذات زيد إذن غير كونه عالما. فما نقول عن ''كونه عالما'' إن لم نقل إنها حال له؟
حاول نُفاة الأحوال تجاوز تلك الإشكالات'' بالقول إن : المسألة ترجع إلى مجرد التسمية : تسمية المحل أي الذات، بـ ''عالم'' أو ''جاهل'' ... إلخ، وبالتالي فما به تشترك المتماثلات وتختلف المختلفات، مثل العالمية والبياضية ... إلخ، إنما هي أسماء وليست أحوالا لمن سمي بها. فأجاب المثبتون بما يلي : أولا، التسمية راجعة إلى المواضعة فهي ليست ضرورية، وبالتالي يمكن تقدير ثبوتها وتقدير انتفائها. وبما أن الأمر هنا يتعلق بعلة عقلية توجب حكما، بمعنى أن كل من قام به العلم، وهو علة في كون العالم عالما، لا بد أن يوجب فيه ذلك العلم حكما، وهو كونه عالما، فإنه لا يجوز ثبوتها وانتفاء أحكامها، أي لا يجوز ثبوت العلم لشخص وانتفاء كونه عالما. ثم ثانيا لأن التسمية قول قائم بقائله، والموصوف بأنه عالم شخص غيره، من المستحيل أن يكون العلم القائم بمحل قول قائم بغيره''. وإذن فلا يبقى إلا أن يكون الحكم (=عالم) الذي توجبه العلة (=علم) حالا لمن قام به. وإذا رفضنا القول بهذه النتيجة بطل التعليل، وبطلان التعليل، في علم الكلام، معناه بطلان الطريق العقلي إلى ثبات الصفات لله تعالى. والأشاعرة كما نعلم يقوم مذهبهم على إثبات الصفات زائدة على الذات، ولذلك تمسك بعضهم بالقول بـ ''الحال'' من هذه الجهة، وإن كانوا قد اضطروا إلى التخلي عن القول بها أو التردد في شأنها من جهة أن القول بها يقتضي الجمع بين النقيضين. (نلاحظ هنا أن رأي هؤلاء الذين قالوا إن مسألة ''الأحوال'' ترجع إلى مسألة ''التسمية'' يلتقي مع النزعة الفلسفية التي عرفها الفكر الفلسفي خلال العصر الوسيط بأوروبا والتي عرفت بـ ''النزعة الاسمية'' Nominalisme، وهي نزعة استمرت قائمة إلى العصر الحديث. ونعود فنطرح السؤال الذي ختمنا به المقال السابق : كيف الخروج من هذه الأزمة، أزمة ''الأحوال'' لدى المتكلمين : المعتزلة والأشاعرة؟
عندما كان أبو حامد الغزالي (450-505هـ) يشرح في كتابه ''معيار العلم'' الذي طبق فيه المنطق (الأرسطي) على مسائل الفقه وعلم الكلام بهدف تبيئة هذا المنطق في الثقافة العربية الإسلامية، بعد أن أصبح منهج الفقهاء (القياس) والمتكلمين (الاستدلال بالشاهد على الغائب) غير قادر على حل المشاكل التي واجهتهما، وفي مقدمتها مسألة ''الحال''، أقول عندما كان الغزالي يشرح المنطق الأرسطي بالأمثلة من الفقه وعلم الكلام، نبه في فصل عقده لشرح معنى ''الجزئي'' والكلي'' في المنطق إلى أن ما أوقع هؤلاء في المشاكل التي غرقوا فيها بسبب ما أطلقوا عليه اسم ''الحال'' هو عدم فهمهم لمقولة ''الكي والجزئي''، يقول: ''إذا سبق إلى الحس شخص زيد حدث في النفس أثر وهو انطباع صورة الإنسانية فيه وهو لا يعلم. وهذه الصورة المأخوذة من الإنسانية المجردة من غير التفات إلى العوارض المخصِّصة لو أضيفت إلى إنسانية عمرو لمطابقته، على معنى أنه لو ظهر للحس فرس بعده يحدث في النفس أثرا آخر، ولو ظهر عمرو لم يتجدد في النفس أثر بل سائر أشخاص الناس في ذلك مستوية، سواء الأشخاص الموجودة والتي يمكن وجودها، لأنه استوت نسبته إلى الكل فسمي كليا بهذا الاعتبار: إذ نسبته إلى كل واحد واحدة... ونسبته إلى النفس والى سائر الصور في النفس نسبة شخصية : فإنه واحد من آحاد العلوم المرتسمة في النفس''. ثم يضيف قائلا : ''وهذا هو الذي أشكل على المتكلمين وعبروا عنه بـ''الحال''، واختلفوا في إثباته ونفيه. وقال قوم ليس بموجود ولا معدوم، وأنكره قوم'' ...
انقلاب تاريخي في الفكر النظري في الإسلام: الانتقال من مفاهيم علم الكلام إلى مفاهيم المنطق والفلسفة، من مفهوم ''الحال'' التي أزمت علم الكلام إلى مفهوم ''الكلي والجزئي'' الذي فتح أبواب ''الكلام'' أمام المنطق والفلسفة. وقد تم ذلك على يد حجة الإسلام أبي حامد الغزالي، المعروف بهجومه على الفلاسفة الإسلاميين (ابن سينا خاصة) وتكفيرهم في مسائل وتبديعهم في أخرى.
إنها قصة أخرى... قصة العلاقة بين علم الكلام والفلسفة.