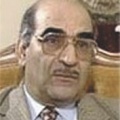الفارابي وإعادة الوحدة إلى الفكر ... العقل والمنطق
يفصل بين الكندي والفارابي نحو ثمانين سنة عرفت حدثين مهمين: الأول ما يعرف بـ''الانقلاب السني'' على المعتزلة زمن المتوكل (232 ـ 247)، وقد كان من آثاره تعرض الكندي لمضايقات، ومغادرة أبي الحسن الأشعري صفوف المعتزلة ليؤسس فرقة عرفت باسمه ''الأشعرية''. أما الحدث الثاني فهو نجاح الدعاة الإسماعيليين في تأسيس دولة لهم في ''إفريقية'' (تونس) تحت رئاسة عبيد الله المهدي ...
هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم يظهر في هذه الأعوام الثمانين أي فيلسوف بالمعنى الاصطلاحي للكلمة، ولكن، في المقابل، نشطت الترجمة والاشتغال بعلوم الأوائل في الاتجاهين:
- الاتجاه الهرمسي الباطني لدى الدعاة الإسماعيليين الذين ارتفعوا بأيديولوجيا حركتهم من مستوى ''رسائل إخوان الصفا'' الموجهة إلى الجمهور إلى مستوى التنظير ''الفلسفي''، مع أبي يعقوب السجستاني أولا، ثم أحمد حميد الدين الكرماني.
- والاتجاه الأرسطي العقلاني الذي بلغ أوجه في هذه المرحلة مع الفارابي وذلك لضلوعه في المنطق الأرسطي الذي اكتمل نقله إلى العربية بترجمة القسم الأساسي منه المسمى ''كتاب البرهان'' أو ''التحليلات الثانية'' على يد معاصر الفارابي أبي بشر متى بن يونس المتوفى سنة 328 هـ.
ولد أبو نصر محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان الفارابي، نسبة إلى ناحية فاراب في تخوم تركستان، حوالي 260هـ. استوطن بغداد وتعلم فيها العربية والمنطق، وسافر إلى حران حيث درس الفلسفة، لينتقل بعد ذلك إلى الشام حيث أقام في كنف سيف الدولة الحمداني (333 ـ 356هـ). زار مصر، ثم عاد واستقر في دمشق نهائيا إلى أن توفي سنة 339 هـ.
عرف الفارابي بالزهد والتقشف والانقطاع إلى التفكير والتأمل والتأليف:''لا يحتفل بأمر مكسب ولا مسكن''، مرابطا عند ''مجتمع ماء أو مشتبك رياض''، وكأنه يحمل وحده مشاكل مجتمعه وهموم معاصريه، بل كأنه حمل نفسه مسؤولية المشكل الحضاري المتفاقم الذي أخذت الحضارة العربية الإسلامية تعاني منه وتئن تحت وطأته قبله بنحو قرن من الزمان. لم يكن يعيش في ظل دولة مركزية قوية كدولة المأمون والمعتصم، ''دولة العقل'' في الإسلام فيعمل على نصرتها والرد على خصومها كما فعل الكندي، بل عاش في ظروف سياسية واجتماعية وفكرية تختلف تماما. لقد تحولت الدول المركزية العظمى، دولة الخلافة العباسية إلى مجرد اسم، إلى دول وإمارات مستقلة متنافسة: السامانيون في خراسان والبويهيون في فارس والعراق والحمدانيون في حلب والأخشيديون في مصر، والأدارسة في المغرب والأمويون في الأندلس والعبيديون في ''إفريقية'' من حدود المغرب إلى حدود مصر. لقد تفككت الإمبراطورية العربية الإسلامية إلى دول متنافسة متناحرة: كثيرة القبائل والطوائف، متعددة الفرق المذاهب، الشيء الذي نال، في آن واحد، من وحدة السلطة واستمرارية الدولة، وبالتالي من وحدة الفكر ودوام المجتمع.
جاء الفارابي إذن في هذه الظروف ليجعل قضيته الأساسية إعادة الوحدة إلى الفكر وإلى المجتمع معا :
- إعادة الوحدة إلى الفكر بالدعوة إلى تجاوز كل من الخطاب ''الكلامي'' السجالي، والخطاب الباطني الهرمسي، والأخذ بخطاب ''العقل الكوني''، العقل الذي يشترك فيه البشر جميعا.
- وإعادة الوحدة إلى المجتمع ببناء العلاقات داخله على نظام جديد يحاكي النظام الذي يسود الكون ويحكم أجزاءه ومراتبه. ومن هنا انصرف الفارابي باهتمامه إلى المنطق من جهة، وإلى الفلسفة السياسية من جهة أخرى.
والحق أن الثقافة العربية الإسلامية مدينة للفارابي في مجال المنطق أكثر مما هي مدينة لغيره ممن جاءوا قبله وبعده. '' فَبَذَّ جميع أهل الإسلام فيها –كما يقول صاعد الأندلسي- وأتى عليهم في التحقق بها فشرح غامضها وكشف سرها وقرب تناولها وجميع ما يحتاج إليه منها، في كتب صحيحة العبارة لطيفة الإشارة منبهة على ما أغفله الكندي وغيره من صناعة التحليل وأنحاء التعليم ...، فكان بذلك ''فيلسوف المسلمين على الحقيقة'' واستحق لقب ''المعلم الثاني'' بعد أرسطو (المعلم الأول). بالفعل لقد اهتم الفارابي بالمنطق اهتماما بالغا، واستوعبه تمام الاستيعاب، واعيا بعمق مركزَ الثقل فيه. لقد رأى فيه الوسيلة التي يمكن بواسطتها جعل حد للفوضى الفكرية السائدة في عصره. ومن هنا حرص على توضيح وظيفة المنطق الاجتماعية، أعني وظيفته على صعيد التعامل الفكري في المجتمع.
وهكذا فإذا كانت ''صناعة المنطق تعطي بالجملة القوانين التي شأنها أن تُقوِّم العقل وتسدّد الإنسان نحو طريق الصواب''، فإن مجال فعالية هذه القوانين يتعدى حدود ''ما نلتمس تصحيحه عند أنفسنا'' إلى ''ما نلتمس تصحيحه عند غيرنا'' أو ''ما يلتمس غيرنا تصحيحه عندنا''. ذلك أنه ''إن كانت عندنا تلك القوانين والتمسنا استنباط مطلوبٍ وتصحيحَه عند أنفسنا لم نُطلق أذهانَنا في طلب ما نصححه مهمَلةً، تسبح في أشياء غير محدودة وتروم المصير إليه من حيث اتفق...، بل ينبغي أن نكون قد علمنا أي طريق ينبغي أن نسلك إليه (مطلوبنا)، وعلى أي الأشياء نسلك، ومن أين نبتدئ في السلوك، وكيف نقف من حيث تتيقن أذهانُنا، وكيف نسعى بأذهاننا على شيء منها إلى أن نُفضي لا محالة إلى ملتمسنا''. ويضيف الفارابي قائلا : ''وتلك تكون حالنا فيما نلتمس تصحيحه عند غيرنا، فإنا إنما نصحح الرأي عند غيرنا بمثل الأشياء والطرق التي نصححه عند أنفسنا، فإن نازعنا في الحجج والأقاويل التي خاطبناه بها في تصحيح ذلك الرأي عنده، وطالَبَنا بوجه تصحيحها له ...، قدرنا أن نبين له جميع ذلك. وكذلك إذا أراد غيرنا أن يصحح عندنا رأيا ما، كان عندنا ما نمتحن به أقاويله وحججه التي رام أن يصحح بها ذلك الرأي...، فنقبل ما نقبله من ذلك عن علم وبصيرة، وإن كان غالط أو غلط تبين من أي وجه غالط أو غلط، فنزيِّفُ ما نزيفه من ذلك عن علم وبصيرة'' .
ويؤكد الفارابي اهتمامه بهذا الدور الذي يقوم به المنطق، أو عليه أن يقوم به، لإزالة الاختلاف وتحقيق وحدة الفكر في المجتمع وذلك من خلال إبرازه للفوضى التي تصيب الحياة الفكرية في المجتمع بسبب الجهل بالمنطق، فيقول: ''فإذا جهلنا المنطق كانت حالنا في جميع هذه الأشياء بالعكس وعلى الضد. وأعظم من جميع ذلك وأقبحه وأشنعه، وأحراه أن يُحذر ويُتقى، هو ما يلحقنا إذا أردنا أن ننظر في الآراء المتضادة أو نحكم بين المتنازعين فيها، وفي الأقاويل والحجج التي يأتي بها كل واحد ليصحح رأيه ويزيف رأي خصمه: فإنا إن جهلنا المنطق لم نقف من حيث نتيقن على صواب من أصاب منهم كيف أصاب، ومن أي جهة أصاب، وكيف صارت حجته توجب صحة رأيه؛ ولا على غلط من غلط منهم أو غالط، كيف ومن أي جهة غالط أو غلط، وكيف صارت حجته لا توجب صحة رأيه، فيعرض لنا عند ذلك إما أن نتحير في الآراء كلها حتى لا ندري أيها صحيح وأيها فاسد، وإما أن نظن أن جميعها على تضادها حق، أو نظن أنه ليس ولا في شيء منها حق، وإما أن نشرع في تصحيح بعضها وتزييف بعض، ونروم تصحيح ما نصحح وتزييف ما نزيف من حيث لا ندري من أي وَجْهٍ هو كذلك''...
الفارابي يدعو إلى التفكير بمنهجية وإلى بناء الحوار على الحجج العقلية التي لا يمكن أن تكون موضوعا لتأويل مغرض أو تحريف متعمد. إنه يريد أن يتجاوز في آن واحد الخطاب الكلامي الجدلي، والخطاب الباطني العرفاني. وهما اللذان كانا ـ في نظره ـ وراء تمزق الفكر والمجتمع. يريد أن يتجاوزهما معا إلى خطاب ''العقل الكوني''، خطاب: ''الأقاويل التي شأنها أن تفيد العلم في المطلوب الذي نلتمس معرفته، سواء استعملها الإنسان فيما بينه وبين نفسه في استنباط ذلك المطلوب، أو خاطب بها غيره في تصحيح ذلك المطلوب: فإنها في أحوالها كلها شأنها أن تفيد العلم اليقين: وهو العلم الذي لا يمكن أصلا أن يكون (يوجد) خلافُه، ولا يمكن أن يرجع الإنسان عنه، ولا أن يعتقد فيه أنه يمكن أن يرجع عنه، ولا تقع عليه شبهة تغلطه ولا مغالطة تزيله، ولا ارتياب ولا تهمة له بوجه ولا سبب''.
ذلك باختصار عن إعادة الوحدة إلى الفكر، وتبقى مسألة إعادة الوحدة للمجتمع موضوعًا للمقال المقبل.