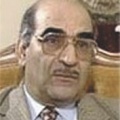الزمان بين المتكلمين والنحاة والمؤرخين
موضوع الزمان من أهم الموضوعات في كل من الفلسفة والتصوف وعلم الاجتماع وعلم النفس... إلخ. لقد بينا في المقال السابق كيف أن الحقل المعرفي العربي يتعامل مع الزمان على أساس الانفصال وليس الاتصال، ونريد في هذا المقال أن نعرض لآراء كل من المتكلمين والنحاة والمؤرخين في هذا الموضوع تمهيدا للانتقال للنتائج التي تترتب على هذا النوع من الرؤية للعالم التي تقوم على الانفصال.
أما المتكلمون فقد تصوروا الزمان على غرار تصورهم للمكان: وهكذا فكما تصوروا المكان على أنه أجسام مؤلفة من أجزاء لا تتجزأ، فكذلك اعتبروا الزمان، فهو عندهم عبارة عن آنات منفصلة تتجدد باستمرار ولا تقبل القسمة. فهي إذن أجزاء لا تتجزأ. هذا من حيث المبدأ؛ أما عن حقيقة هذه الآنات أو الأجزاء التي لا تتجزأ من الزمان فقد قال بعضهم: "الوقت عرض ولا نقول ما هو ولا نقف على حقيقته"، بل إن منهم من أنكر الزمان جملة فجوزوا وجود أشياء لا في زمان. يقول الأشعري: "واختلفوا (يعني المعتزلة): هل يجوز وجود أشياء لا في أوقات، فجوز ذلك مجوز وأنكره منكرون. وقال قائلون: الوقت ما تؤقته للشيء. فإذا قلت: "آتيك قدوم زيد"، جعلت قدوم زيد وقتا لمجيئك". وقال أبو الهذيل العلاف: "الوقت هو الفرق بين الأعمال، وهو مدى ما بين عمل وعمل، وأنه يحدث مع كل وقت فعل". ولا يختلف موقف الأشاعرة عن موقف المعتزلة إلا في بعض التفاصيل. يقول الإيجي: "مذهب الأشاعرة في الزمن أنه متجدد يقدر به متجدد، وقد يتعاكس بحسب ما هو متصور للمخاطب: فإذا قيل متى جاء زيد؟ يقال: عند طلوع الشمس، إن كان مستحضرا لطلوع الشمس. ثم إذا قال غيره: متى طلوع الشمس؟ يقال: حين جاء زيد، لمن كان مستحضرا لمجيء زيد".
وبالجملة، فالذي يمكن ضبطه من أقوال المتكلمين، معتزلة وأشاعرة، عن الزمان، ثلاثة أمور:
أولها: أنهم تصوروا الزمان مؤلفا من أجزاء صغيرة منفصلة متعاقبة لا تقبل القسمة، ومن هنا قولهم: "العرض لا يبقى زمانين"، وهكذا فكما تتجدد الأعراض باستمرار تتجدد آنات الزمان باستمرار كذلك.
ثانيها: أنهم ربطوا بين الزمن والمتزمن فيه، مثلما ربطوا بين المكان والمتمكن فيه، وبعبارة أخرى هم لا يتصورون المكان ولا الزمان مستقلين عن محتوياتهما، بل يربطون بين الشيء ومكانه وزمانه ويجعلون من ذلك وحدة واحدة.
ثالثها: أنهم نظروا إلى الزمان من حيث وظيفته أي من حيث هو تقدير الحوادث بعضها بعضا، ولكن دون أن يعني ذلك استقلال الزمن عن الحدث، بل "يجب عندهم أن يكون الوقت والمؤقت جميعا حادثين، لأن معتبرهما بالحدث لا غير".
هذا التصور الجزيئي للزمان نجد امتداداته عند النحاة الذين اضطربوا في شأن "الحال" أعني الفعل الدال على الحاضر، مثل قولنا: "زيد جالس". فالكوفيون جعلوا زمن الفعل قسمين فقط: الماضي كـ "ضرب" والمستقبل كـ "يضرب". أما الحال أو الزمن الحاضر (المعبر عنه بـالفعل "المضارع") فلا وجود له عندهم إلا كوصف للقائم بالفعل مثل: "ضارب" وسموا هذه الصيغة بـ "الفعل الدائم". أما البصريون فقد رفضوا إطلاق اسم "الفعل" على هذه الصيغة، ليس فقط لأنها اسم يجري عليه ما يجري على الأسماء من قوانين وضوابط نحوية، بل أيضا لأن عبارة "الفعل الدائم" لا يستسيغها الحقل المعرفي البياني. ذلك أن "الفعل" في هذا الحقل هو عبارة عن حركة الفاعل، والحركة عرض، فهي لا تبقى زمانين. وإذن فعبارة "الفعل الدائم" عبارة متناقضة لأن الفعل مجموع أجزاء لا تتجزأ، منفصلة متجددة لا تدوم.
وقد حاول الزجاجي رفع هذا التناقض بالقول: "الفعل على الحقيقة ضربان كما قلنا، ماض ومستقبل. فالمستقبل ما لم يقع بعد ولا أتى عليه زمان ولا خرج من العدم إلى الوجود. والفعل الماضي ما تقضى وأتى عليه زمانان لا أقل. زمان وجد فيه وزمان خُبِّر فيه عنه. فأما فعل "الحال" فهو المتكون في حال خطاب المتكلم، لم يخرج إلى حيز المضي والانقطاع ولا هو في حيز المنتظر الذي لم يأت وقته، فهو المتكون في آخر الوقت الماضي وأول الوقت المستقبل. ففعل الحال في الحقيقة مستقبل لأنه يكون أولا أولا، فكل جزء خرج منه إلى الوجود صار في حيز المضي".
وإذن فالفعل الدال على الحال ليس فعلا متصلا، بل هو مجموع أجزاء الزمان المنفصلة، المتجددة التي يستغرقها خطاب المتكلم. ومن هنا يكون "الحال" صفة لزمن الفاعل وليس لزمن الفعل. وزمن الفاعل هو زمن حركته، والحركة لا تبقى زمانين. وواضح أن استبعاد "الحال" - أو الزمن الحاضر- بهذا الشكل يؤدي إلى نفي الزمان جملة. نعم، كان من المتكلمين من أنكر وجود الزمان، كما كان منهم من أنكر وجود المكان، باعتبار أن الموجود هو المتمكن والمتزمن لا غير.
وكما نجد عند النحاة امتدادات لهذا التصور الجزيئي للزمان الذي كرسه المتكلمون في الحقل البياني بأجمعه، نجده كذلك عند المؤرخين العرب بكيفية عامة. ذلك أن تصور المؤرخين الإسلاميين للحدث التاريخي كان محكوما إلى حد كبير بالتصور الجزيئي للزمان كما كرسه المتكلمون. فالتاريخ عندهم هو "التوقيت"، أي تسجيل وقت حدوث الحوادث. ولما كان الوقت، في التصور البياني، يقوم على الانفصال، كما بينا، فإن نظرة المؤرخ، في الحقل المعرفي البياني، لا بد أن تكون مبنية هي الأخرى على الانفصال، وبالتالي فما سيهمه هو تعيين وقت حدوث الحادثة، وليس علاقتها مع ما قبلها وما بعدها، مما يجعل من التاريخ عبارة عن "فعاليات البشر في أوقات معينة" ويجعل مهمة المؤرخ منحصرة في ضبط أوقات هذه الفعاليات. وهذا ما يعكسه تصورهم للكتابة التاريخية. يقول السخاوي: "التأريخ في اللغة: الإعلام بالوقت.. وفي الاصطلاح: التعريف بالوقت الذي تضبط به الأحوال، من مولد الرواة والأئمة، ووفاة وصحة وعقل وبدن ورحلة وحج وحفظ وضبط وتوثيق وتجريح وما أشبه، هذا مما مرجعه الفحص عن أحوالهم في ابتدائهم وحالهم واستقبالهم، ويلتحق به ما يتفق من الحوادث والوقائع الجليلة من ظهور ملمة وتجديد فرض وخليفة ووزير وغزوة وملحمة وحرب وفتح بلد... أو دونها كبناء جامع أو مدرسة أو قنطرة أو رصيف... والحاصل أنه فن يبحث فيه عن وقائع الزمان من حيثية التعيين والتوقيت".
وبعد، أليست رؤية العرب للعالم، اليوم كما في الأمس إلا قليلا منهم - محكومة بمبدأ "الجوهر الفرد"، مبدأ الانفصال؟