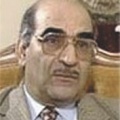الكندي: دفاع عن الدين وعن الفلسفة معا
الكندي (185-252هـ) هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح من قبيلة كندة العربية اليمنية، وصفه ابن النديم بأنه «فاضل دهره وواحد عصره في معرفة العلوم القديمة بأسرها ويسمى فيلسوف العرب وكتبه في علوم مختلفة مثل المنطق والفلسفة والهندسة والحساب والارثماطيقى والموسيقى والنجوم وغير ذلك». ذكر له ما يقرب من 270 رسالة في هذه العلوم.
إذا نظرنا إلى رسائل الكندي في وضعها الأول، أي كـ «كتب» أو رسائل منفصلة قصيرة في الغالب، أرسطوطاليسية الاتجاه والمضمون، إسلامية العقيدة، فضلا عن رسائل خاصة بالرد على المانوية وغيرها، وأخرى تدافع عن ثوابت العقيدة الإسلامية... إذا نظرنا إلى رسائل الكندي من هذه الزاوية واستحضرنا تاريخ كتابتها (أي في خلافة المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل 198-247 هـ، وكنا قد ذكرنا في المقال السابق أن رسائل إخوان الصفا كتبت خلال سنوات 212-229)، أقول: إذا نظرنا إلى رسائل الكندي من خلال هذه المعطيات صار بإمكاننا أن نؤكد أنها كانت ردا على رسائل إخوان الصفا، وبالتحديد على أيديولوجيتهم الدينية الباطنية الهرمسية، وأن قيام الكندي بهذا الرد لم يكن معزولا لا عن مغزى حلم المأمون بأرسطو ولا عن تأسيس هذا الأخير «بيت الحكمة» لترجمة العلوم الفلسفية اليونانية الأرسطية الطابع، أعني البعيدة عن التأثيرات الغنوصية الهرمسية، (كنا نشرنا ثلاث مقالات عن حلم المأمون ودلالته السياسية والأيديولوجية في مجلة «المجلة» خلال شهر مايو 2008).
لقد كتب الكندي رسائل خاصة «في الرد على المانوية» و«الرد على المثنزية» وفي «نقض مسائل الملحدين». كما كتب رسائل «في تثبيت الرسل عليهم السلام». و«في بطلان قول من زعم أن جزءا لا يتجزأ». و«في افتراق الملل في التوحيد وأنهم مجمعون على التوحيد وكل قد خالف صاحبه».
من جهة أخرى تصدى الكندي للهرمسية من خلال إفساد أطروحاتها الأساسية فأعلن إبطال إمكانية تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب وفضة، كما عارض التصور الهرمسي الغنوصي للإله المتعالي وما يرتبط به من إبطال النبوة وذلك في رسالة بعنوان «كتاب في التوحيد على سبيل أصحاب المنطق... وكتاب في إثبات النبوة على تلك السبيل»، سبيل أصحاب المنطق المناقضة لسبيل أصحاب العرفان. كما عارض فكرة «الفيض» ونظرية العقول السماوية... هو يرفض أن يسمي الله عقلا حتى لا يتكثر بتكثر معقولاته، فالله عنده واحد من كل جهة : إنه «الواحد الحق ليس هو شيء من المعقولات ولا هو عنصر ولا جنس ولا نوع... ولا نفس ولا عقل... ولا واحد بالإضافة إلى غيره، بل واحد مرسل». «واحد مرسل» معناه : ليس هناك إلى جانب الله أي كائن إلهي آخر مثل «العقل الكلي» أو «العقل العاشر» إلخ.
وهكذا ففي مجال المعرفة يميز الكندي تمييزا حاسما بين «علم الرسل» وبين «علم سائر البشر». الأول يكون «بلا طلب ولا تكلف ولا بحث ولا بحيلة الرياضيات والمنطق ولا بزمان، بل مع إرادته جل وتعالى بتطهير أنفسهم وإنارتها بالحق بتأييده وتسديده وإلهامه ورسالاته. فإن هذا العلم خاص بالرسل صلوات الله عليهم دون البشر، وأحد خوالجهم العجيبة، أعني آياتهم الفاصلة لهم عن غيرهم من البشر». أما الثاني، أي علم البشر، فواضح من النص أنه يكون بالطلب والبحث والاستدلال وفي زمان... ومن دون شك فإن تأكيد الكندي على أن النبوة خاصة بالرسل وأنها آيتهم التي تفصلهم عن سائر البشر معناه سد الباب أمام القول بأي طريق آخر للمعرفة وبالتالي رفض العرفان. إن المعرفة عند الكندي إما حسية وأداتها الحس وموضوعها الأشياء الحسية، وإما عقلية وأداتها العقل وموضوعها المعقولات أي المفاهيم المجردة، وإما إلهية وأداتها الرسل المبلغة عن الله وموضوعها عالم الربوبية وتكون «بالإيجاز والبيان وقرب السبل والإحاطة بالمطلوب».
أما في مجال الوجود فمعروف أن الكندي يتبنى المبدأ الديني القائل بـ «حدوث العالم»، وهو يوظف لنصرته وإضفاء المعقولية عليه حشدا من مفاهيم الفلسفة الأرسطية. إنه يبرهن على أن جرم العالم متناه وأن الزمان متناه وأن الحركة متناهية كذلك، ويستنتج من ذلك تناهي العالم حدوثَه. و»حدوث العالم» معناه أن الله أحدثه من لا شيء وبغير واسطة. فالله «هو العلة الأولى التي لا علة لها، الفاعلة التي لا فاعل لها، المتممة التي لا متمم لها، والمؤيس (الموجِد) الكلَّ عن ليس (لا شيء) والمُصيِّر بعضه لبعض سببا وعللا».
وهكذا، وضدا على استخفاف إخوان الصفا، بمنهج المتكلمين ومنطق الفلاسفة وادعاء عجز العقل عن إدراك الحقيقة الدينية التي لا تنال إلا بمعلم إمام، يؤكد الكندي أن التمييز بين معرفة الرسل ومعرفة سائر البشر لا يعني وجود تناقض بينهما، فالحقيقة الدينية لا تتناقض مع الحقيقة العقلية بل هما مظهران لحقيقة واحدة. يقول «إن قول الصادق محمد صلوات الله عليه وما أدى عن الله عز وجل لموجود جميعا بالمقاييس العقلية التي لا يدفعها إلا من حرم صورة العقل واتحد بصورة الجهل من الناس! فأما من آمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه ثم جحد ما أتى به وأنكر ما تأول ذوو الدين والألباب ممن أخذ عنه صلوات الله عليه فظاهر الضعف في تمييزه، إذ يبطل ما يثبته وهو لا يشعر بما أتى من ذلك، أو يكون من جهل العلة التي أتى بها الرسل صلوات الله عليهم ولم يعرف اشتباه الأسماء فيها والتصريف والاشتقاقات اللواتي وإن كانت كثيرة في اللغة العربية فإنها عامة لكل لغة». الحقيقة الدينية إذن لا تتناقض مع العقل، غير أنها في بعض الأحيان لا تنال من ظاهر النص بل قد يستلزم الأمر اللجوء إلى التأويل. والتأويل في هذه الحالة لا يعني اختراق المجال التداولي الذي نزل فيه القرآن إلى مجال آخر بعيد عنه كما يفعل أهل «الباطن». إن الكندي يؤكد على احترام أساليب اللغة العربية في التعبير، في ذات الوقت الذي ينحو فيه بالتأويل منحى عقليا صرفا. وهكذا فعندما سأله تلميذ المعتصم عن معنى قوله تعالى: «والنجم والشجر يسجدان»(الرحمن-6) نبه على فساد التقيد بظاهر الآية لكون النجوم لا يمكن أن يقع منها السجود الحقيقي المنصوص عليه في الشرع عند الصلاة، وقال إن معنى سجود النجوم هو جريانها في مداراتها والتزامها حركاتها التي تنشأ عنها الظواهر الطبيعية الجوية والأرضية، وبالتالي أداؤها الوظيفة التي حددها لها خالقها، وظيفة الحفاظ على نظام العالم. هذا في حين يتجه التأويل الباطني الهرمسي إلى اعتبار النجوم كائنات عقلية إلهية، أو على الأقل تسيرها «عقول سماوية إلهية»، هي التي تقوم بالسجود والتسبيح... إلخ.
وكما عمل الكندي على نصرة «المعقول» الديني العربي ضدا على الغنوص المانوي والتأويل الباطني عمل في الوقت نفسه على الدفاع عن «المعقول العقلي» أعني الفلسفة وعلومها. إن الكندي يدعو إلى ضرورة الأخذ من «الأوائل» وتدارك ما قصروا فيه، مع احترامهم والاعتراف بفضلهم، يقول : «ومن أوجب الحق أن لا نذم من كان أحد أسباب منافعنا الصغار الهزيلة، فكيف بالذين هم أكبرُ أسبابِ منافعنا العظام الحقيقية الجدية ؟ فإنهم وإن قصروا عن بعض الحق فقد كانوا لنا أنسابا وشركاء في ما أفادونا من ثمار فكرهم التي صارت لنا سبلا وآلات مؤدية إلى علم كثير مما قصروا عن نيل حقيقته… فينبغي أن يعظم شكرنا للآتين بيسير من الحق فضلا عمن أتى بكثير من الحق، إذ أشركونا في ثمار فكرهم وسهلوا لنا المطالب الحقِّية الخفية بما أفادونا من المقدمات المسهِّلة لنا سبل الحق، فإنهم لو لم يكونوا لم يجتمع لنا، مع شدة البحث في مددنا كلها، هذه الأوائل الحقٍّية التي بها تُخرجنا إلى الأواخر من مطلوباتنا الخفية. فإن ذلك إنما اجتمع في الأعصار السالفة المتقادمة، عصر بعد عصر، إلى زماننا هذا مع شدة البحث ولزوم الدأب وإيثار التعب». ويضيف الكندي قائلا : «فينبغي لنا أن لا نستحي من استحسان الحق واقتناء الحق من أين أتى، وإن أتى من الأجناس القاصية عنا والأمم المتباينة، فإنه لا شيء أولى بطلب الحق من الحق». أما الذين يهاجمون الفلسفة الحقيقية فهم «من أهل الغربة عن الحق وإن تتوجوا بتيجان الحق من غير استحقاق»، إنهم إنما يعادون الفلسفة «ذبا عن كراسيهم المزورة التي نصبوها من غير استحقاق، بل للترؤس والتجارة بالدين وهم عدماء الدين، لأن من تجر بشيء باعه ومن باع شيئا لم يكن له. فمن تجر بالدين لم يكن له دين ويحق أن يتعرى من الدين من عاند قُنية علم الأشياء بحقائقها وسماها كفرا، لأن في علم الأشياء بحقائقها علم الربوبية وعلم الوحدانية وعلم الفضيلة وجملة علم كل نافع والسبيل إليه والبعد عن كل ضار والاحتراس منه، واقتناء هذه جميعا هو الذي أتت به الرسل الصادقة من الله جل ثناؤه».